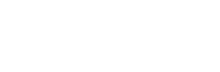<ins class="adsbygoogle" style="display: inline-block; width: 336px; height: 0px;" data-ad-client="ca-pub-2872189824321098" data-ad-slot="8740910178" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display: inline-table; border: medium none; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 336px; background-color: transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display: block; border: medium none; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 336px; background-color: transparent; overflow: hidden; opacity: 0;"></ins></ins></ins>
هي سورة مكية نزلت بعد الشعراء، وآيها ثلاث وتسعون.
ومناسبتها ما قبلها من وجوه:
(1) إنها كالتتمة لها، إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء قصص داود وسليمان.
(2) إن فيها تفصيلا وبسطا لبعض القصص السالفة كقصص لوط وموسى عليهما السلام.
(3) إن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله.
(4) تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم، وإصرارهم على الكفر به، والإعراض عنه.
[سورة النمل (27): الآيات 1 الى 3] بسم الله الرحمن الرحيم
طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3)
الإيضاح
(طس) تقدم القول في المراد من فواتح السور، وأن الأصح أنها حروف مقطعة جاءت للتنبيه نحو ألا ويا التي للنداء، وينطق بأسمائها فيقال: (طا - سين).
(تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) أي إن هذه الآيات التي أنزلتها إليك أيها الرسول لآيات القرآن، وآيات كتاب بيّن لمن تدبره وفكر فيه أنه من عند الله أنزله إليك، لم تتقوّله أنت ولا أحد من خلقه، إذ لا يستطيع ذلك مخلوق ولو تظاهر معه الجن والإنس.
والمراد بالكتاب المبين: القرآن، وعطفه عليه كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما يقال هذا فعل السخي والجواد الكريم.
(هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) أي هي تزيد المؤمنين هدى على هداهم كما قال: « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » وهي تبشرهم برحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
ولما كان وصف الإيمان خفيا ذكر ما يلزمه من الأمور الظاهرة فقال:
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) أي إن المؤمنين حق الإيمان هم الذين يعملون الصالحات، فيقيمون الصلاة المفروضة على أكمل وجوهها، ويؤدون الزكاة التي تطهّر أموالهم وأنفسهم من الأرجاس، ويوقنون بالمعاد إلى ربهم، وأن هناك يوما يحاسبون فيه على أعمالهم خيرها وشرّها، فيذلّون أنفسهم في طاعته، رجاء ثوابه وخوف عقابه.
وليسوا كأولئك المكذبين به الذين لا يبالون. أحسنوا أم أساءوا، أطاعوا أم عصوا، لأنهم إن أحسنوا لا يرجون ثوابا، وإن أساءوا لم يخافوا عقابا.
[سورة النمل (27): الآيات 4 الى 5] إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5)
تفسير المفردات
يعمهون: أي يتحيرون ويترددون في أودية الضلال، الأخسرون: أي أشد الناس خسرانا، لحرمانهم الثواب، واستمرارهم في العذاب.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه أن المؤمنين يزيدهم القرآن هدى وبشرى، إذ هم به يستمسكون ويؤدون ما شرع من الأحكام على أتم الوجوه - أردف هذا ببيان أن من لا يؤمن بالآخرة يركب رأسه، ويتمادى في غيه، ويعرض عن القرآن أشد الإعراض، ومن ثم تراه حائرا مترددا في ضلاله، فهو في عذاب شديد في دنياه لتبلبله، وقلقه واضطراب نفسه، وفى الآخرة له أشد الخسران، لما يلحقه من النكال والوبال والحرمان من الثواب والنعيم الذي يتمتع به المؤمنون.
الإيضاح
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) أي إن الذين لا يصدقون بالآخرة وقيام الساعة والمعاد إلى الله بعد الموت، وبالثواب والعقاب - حبّبنا إليهم قبيح أعمالهم، ومددنا لهم في غيهم، فهم في ضلالهم حيارى تائهون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يفكرون في عقبى أمرهم، ولا ينظرون إلى ما يئول إليه سلوكهم.
قال الزجاج: أي جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه بأن جعلناه مشتهى بالطبع، محبوبا إلى النفس.
(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) في الدنيا بقتلهم وأسرهم حين قتال المؤمنين كما حدث يوم بدر.
(وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أي وهم في الآخرة أعظم خسرانا مما هم فيه في الدنيا، لأن عذابهم فيها مستمر لا ينقطع، وعذابهم في الدنيا ليس بدائم بل هو زائل لا بقاء له.
قصص موسى عليه السلام [سورة النمل (27): الآيات 6 الى 14] وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارًا سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)
تفسير المفردات
لتلقى: أي لتلقّن وتعطى، آنست: أي أبصرت إبصارا حصل لي به أنس، بخبر: أي عن الطريق وحاله، بشهاب: أي بشعلة نار، قبس: أي قطعة من النار مقبوسة ومأخوذة من أصلها، تصطلون: أي تستدفئون بها، قال الشاعر:
النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل
جان: أي حية صغيرة سريعة الحركة، ولّى مدبرا: أي التفت هاربا، ولم يعقب: أي لم يرجع على عقبه ولم يلتفت إلى ماوراءه من قولهم: عقّب المقاتل إذا كرّ بعد الفرّ، من غير سوء: أي من غير برص ولا نحوه من الآفات، آيات: أي معجزات دالة على صدقك، مبصرة: أي بينة واضحة، جحدوا بها: أي كذبوا، واستيقنتها أنفسهم: أي علمت علما يقينيا أنها من عند الله، وعلوا: أي ترفعا واستكبارا.
المعنى الجملي
بعد أن وصف عز اسمه القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين، وأن من أعرض عنه كان له الخسران المبين - أردفه بذكر حال المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا له.
الإيضاح
(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) أي وإنك أيها الرسول لتحفظ القرآن وتعلّمه من عند حكيم بتدبير خلقه، عليم بأخبارهم وما فيه الخير لهم، فخبره هو الصدق، وحكمه هو العدل كما قال: « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ».
ثم خوطب صلى الله عليه وسلم وأمر بتلاوة بعض ما تلقاه من لدنه عز اسمه تقريرا لما قبله وتحقيقا له بقوله:
(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارًا سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي واذكر أيها الرسول لقومك حين قول موسى لأهله وقد ساربهم فضلّ الطريق في ليل دامس وظلام حالك، فرأى نارا تأجج وتضطرب، إني أبصرت نارا سآتيكم منها إما بخبر عن الطريق أو آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها، وكان كما قال: فإنه رجع منها بخبر عظيم، واقتبس نورا جليلا.
وقد كان هذا حين مسيره من مدين إلى مصر ولم يكن معه سوى امرأته، وكانا يسيران ليلا فاشتبه عليهما الطريق والبرد شديد.
وفي مثل هذه الحال يستبشر الناس بمشاهدة النار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة وأمن الطريق ومن الانتفاع بها للاصطلاء، ومن ثم قال لها هذه المقالة.
(فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي فلما وصل إلى النار نودى بأن بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، ومكانها هي البقعة المباركة المذكورة في قوله: « نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ » ومن حولها من في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات ومهبط الخيرات، لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتا.
وقوله سبحان الله تنزيه لنفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته وإيذان بأن مدبر ذلك الأمر هو رب العالمين.
أخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات (أنوار) وجهه كل شيء أدركه بصره » ثم قرأ أبو عبيدة « أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ».
وفي التوراة: جاء الله من سيناء، وأشرف من ساعير، واستعلى من جبل فاران، فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منها، واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم (وفاران مكة).
ولما تشوقت النفس إلى تحقيق ما يراد بالتصريح قال تعالى تمهيدا لما أراد إظهاره على يد موسى من المعجزات الباهرة:
(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي يا موسى إن الذي يخاطبك ويناجيك هو ربك الذي عزّ كل شيء وقهره، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله.
ثم أرى موسى آية تدل على قدرته، ليعلم ذلك علم شهود فقال:
(وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي وألق عصاك، فلما ألقاها انقلبت حية سريعة الحركة، فلما رآها كذلك ولّى هاربا خوفا منها ولم يلتفت وراءه من شدة فرقه.
وحينئذ تاقت النفس إلى معرفة ما قيل إذ ذاك فقال:
(يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) أي لا تخف مما ترى، فإني لا يخاف عندي رسلي وأنبيائى الذين اختصهم وأصطفيهم بالنبوة.
(إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي لكن من ظلم من سائر العباد، فإنه يخاف إلا إذا تاب، فبدل بتوبته حسنا بعد سوء، فإني أغفر له وأمحو ذنوبه وجميع آثارها كما فعل السحرة الذين آمنوا بموسى، وفى هذا بشارة عظيمة لسائر البشر، فإن من عمل ذنبا ثم أقلع عنه وتاب وأناب، فإن الله يتوب عليه كما قال: « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا ثُمَّ اهْتَدى » وقال: « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ».
ثم أراه جلت قدرته آية أخرى ذكرها بقوله:
) أي وأدخل يدك في جيب « مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر » فميصك تخرج بيضاء بياضا عظيما، ولها شعاع كشعاع الشمس بلا آفة بها من برص أو غيره.
والآية الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى حيوان، والثانية بتغيير يده نفسها وقلب أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية.
(فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) أي هاتان آيتان من تسع آيات أؤيدك بهن، وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه كما قال: « وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ».
ثم علل إرساله إليهم بالخوارق بقوله:
(إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ) أي لأنهم قوم خرجوا عما تقتضيه الفطرة ويوجبه العقل بادعاء فرعون الألوهية وتصديقهم له في ذلك.
وبعدئذ ذكر ما حدث لهم حين أتاهم بالبراهين من ربه فقال:
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي فلما جاءت فرعون وقومه أدلتنا الواضحة المنيرة الدالة على صدق الداعي - أنكروها وقالوا هذا سحر بين لائح يدل على مهارة فاعله وحذق صانعه.
ثم بين أن هذا التكذيب إنما كان باللسان فحسب لا بالقلب فقال:
(وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) أي وكذبوا بها بألسنتهم وأنكروا دلالتها على صدقه وأنه رسول من ربه، لكنهم علموا في قرارة نفوسهم أنها حق من عنده، فخالفت ألسنتهم قلوبهم، ظلما للآيات، إذ حطوها عن مرتبتها العالية وسمّوها سحرا، ترفعا عن الإيمان بها كما قال في آية أخرى: « فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْمًا عالِينَ ».
والخلاصة - إنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بها وهم يعلمون أنها من عند الله.
(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) أي فانظر أيها الرسول ما آل إليه أمر فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الذي فيه العبرة للظالمين، ومن إخراجهم من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم.
وفي هذا تحذير للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين لما جاء به من عند ربه، أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لعلهم يقلعون عن عنادهم واستكبارهم حتى لا تنزل بهم القوارع ويأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون.
قصص داود وسليمان عليهما السلام [سورة النمل (27): الآيات 15 الى 19] ولَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْمًا وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19)
تفسير المفردات
ورث سليمان داود: أي قام مقامه في النبوة والملك، منطق الطير: أي فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت، حشر: أي جمع، يوزعون: أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد، وادي النمل: واد بأرض الشام لا يحطمنكم: أي لا يكسرنكم ويهشمنكم، أوزعنى: أي يسر لي.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر قصص موسى صلى الله عليه وسلم تقريرا لما قبله ببيان أنه تلقاه من لدن حكيم عليم - أردفه قصص داود وسليمان، وذكر أنه آتى كلا منهما طائفة من علوم الدين والدنيا، فعلّم داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلّم سليمان منطق الطير، ثم بين أن سليمان طلب من ربه أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه وعلى والديه، وأن يمكنه من العمل الصالح وأن يدخله جنات النعيم.
الإيضاح
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْمًا، وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) أي ولقد أعطينا داود وسليمان ابنه عليهما السلام طائفة عظيمة من العلم، فعلمنا داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلمنا سليمان منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال ونحو ذلك مما لم نؤته أحدا ممن قبلهما، فشكر الله على ما أولاهما من مننه، وقالا الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن، على كثير من المؤمنين من عباده الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا.
وفي الآية إيماء إلى فضل العلم وشرف أهله من حيث شكرا عليه وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا شيئا دونه مما أوتياه من الملك العظيم: « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ » وفيها تحريض للعلماء على أن يحمدوا الله على ما آتاهم من فضله، وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن عباد الله من يفضلهم فيه.
(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) أي قام مقامه في النبوة والملك بعد موته، وسخّرت له الريح والشياطين.
قال قتادة في الآية: ورث نبوته وملكه وعلمه، وأعطى ما أعطى داود، وزيد له تسخير الريح والشياطين، وكان أعظم ملكا منه وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، شاكرا لنعم الله تعالى ا هـ.
ثم ذكر بعض نعم الله عليه:
(وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) أي وقال متحدثا بنعمة ربه، ومنبها إلى ما شرّفه به، ليكون أجدر بالقول: يا أيها الناس إن ربى يسرّ لي فهم ما يريده الطائر إذا صوّت، فأعطاني قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التي يومئ إليها فضلا منه ونعمة.
وقد اجتهد كثير من الباحثين في العصر الحاضر فعرفوا كثيرا من لغات الطيور أي تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة من حزن وفرح وحاجة إلى طعام وشراب واستغاثة من عدوّ، إلى نحو ذلك من الأغراض القليلة التي جعلها الله للطير.
وفي هذا معجزة لكتابه الكريم لقوله في آخر السورة: « وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها ».
وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيرا من الأمم تبحث في لغات الطيور والحيوان والحشرات كالنمل والنحل، وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع أغراضها، فكأنه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن وعلّمتها سليمان، وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتى، ويطلع الناس على عجائب صنعي فيها.
(وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ) مما نحتاج إليه في تدبير الملك، ويعيننا في ديننا ودنيانا.
وهذا أسلوب يراد به الكثرة من أي شيء، كما يقال فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء، وسيأتي في مقال الهدهد عن بلقيس. « وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ».
(إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) أي إن هذا الذي أوتيناه من الخيرات لهو الفضل المبين الذي لا يخفى على أحد.
ثم ذكر بعض ما أوتيه سليمان بقوله:
(وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي وجمع له عساكره من مختلف النواحي ليحارب بهم من لم يدخل في طاعته فهو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، وقال ابن عباس لكل صنف وزعة ترد أولاها على أخراها، لئلا تتقدمها في السير كما يصنع الملوك. وقال الحسن: لا بد للناس من وازع: أي سلطان يكفلهم. وقال عثمان بن عفان: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن.
(حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ: يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي حتى إذا أشرفوا على وادي النمل صاحت نملة بما فهم منه سليمان أنها تأمرهم بأن يدخلوا مساكنهم خوفا من تحطيم سليمن وجنوده لهم وهم لا يشعرون بذلك.
(فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) أي فضحك متعجبا من حذرها وتحذيرها والهداية التي غرسها الله فيها، مسرورا بما خصه الله من فهم مقاصدها، وقال رب ألهمنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل عملا تحبه وترضاه، وتوفنى مسلما وألحقنى بالصالحين من عبادك.
وخلاصة ذلك - كأنه قال: العلم غاية مطلبى وقد حصلت عليه، ولم يبق بعد ذلك إلا أن أطلب التوفيق للشكر عليه بالعمل الصالح الذي ترضاه، وأن أدخل في عداد الصالحين من آبائي الأنبياء وغيرهم.
تذكرة وعبرة بالآية قد دلّ بحث الباحثين في معيشة النمل على مالها من عجائب في معيشتها وتدبير شئونها، فإنها لتتخذ القرى في باطن الأرض، وتبنى بيوتها أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات، وتملؤها حبوبا وقوتا للشتاء، وتخفى ذلك في بيوت من مساكنها منعطفات إلى فوق، حذرا من ماء المطر.
وفي هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم والسياسة، فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى طريقة سياستها، وحكمتها وتذبيرها لأمورها، وأنها تفعل ما يفعل الملوك، وتدبّر وتسوس كما يسوس الحكام.
ولم يذكره الكتاب الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء، فيفهموا حال هذه الكائنات، وكيف أن النمل أجمعت أمرها على الفرار خوفا من الهلاك كما تجتمع على طلب المنافع، وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائهة في أودية الضلال، وهي أدنى حالا من الحشرات والديدان: « وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ».
[سورة النمل (27): الآيات 20 الى 26] وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)
تفسير المفردات
التفقد: طلب ما فقد، بسلطان مبين، أي بحجة واضحة، والإحاطة بالشيء علما علمه من جميع جهاته، وسبأ: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلة باليمن، ونبأ: أي خبر عظيم، والعرش: سرير الملك، عن السبيل: عن سبيل الحق والصواب والخبء: هو المخبوء من كل شيء كالمطر وغيره من شئون الغيب.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر في سابق الآيات أنه سخر لسليمان الجن والإنس والطير وجعلهم جنودا له - ذكر هنا أنه احتاج إلى جندى من جنوده وهو الهدهد، فبحث عنه فلم يجده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أبدى له عذرا يبرئه، فحضر بعد قليل وقص عليه خبر مملكة باليمن من أغنى الممالك وأقواها تحكمها امرأة هي بلقيس ملكة سبأ، ووصف له مالها من جلال الملك وأبّهته وأنها وقومها يعبدون الشمس لا خالق الشمس العليم بكل شيء في السموات والأرض، والعليم بما نخفى وما نعلن، والعليم بالسر والنجوى، وهو رب العرش العظيم.
الإيضاح
(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) أي وطلب ما فقد من الطير بحسب ما تقتضيه العناية بأمر الملك من الاهتمام بالرعايا ولا سيما الجند فقال: الهدهد حاضر ومنع مانع من رؤيته كساتر ونحوه؟ ثم لاح له أنه غائب فقال أم كان قد غاب قبل ذلك ولم أشعر به؟.
وخلاصة ذلك - أغاب عنى الهدهد الآن فلم أره حين تفقده، أم كان قد غاب من قبل ولم أشعر بغيبته.
ثم توعده بالعذاب إذا لم يجد سببا يبرر به غيبته فقال:
(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي لأعذبنه بحبسه مع ضده في قفص، ومن ثم قيل: أضيق السجون معاشرة الأضداد، أو بإبعاده من خدمتى، أو بإلزامه بخدمة أقرانه أو نحو ذلك، أو لأذبحنه ليعتبر به سواه أو ليأتينى بحجة تبين عذره.
والخلاصة - إنه ليعذبنه بأحد الأمرين الأولين إن لم يكن الأمر الثالث.
ثم ذكر أنه جاء بعد قليل وبين أن غيابه كان لأمر هامّ لدى سليمان.
(فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) أي فغاب مدة قصيرة بعد سؤال سليمان عنه ثم جاء فسأله: ما الذي أبطأ بك عني؟ فقال: اطلعت على ما لم تطلع أنت ولا جنودك عليه، على سعة علمك واتساع أطراف مملكتك.
وقد بدأ كلامه بهذا التمهيد، لترغيبه في الإصغاء إلى العذر، واستمالة قلبه إلى قبوله، ولبيان خطر ما شغله، وأنه أمر جليل الشأن يجب أن يتدبر فيه، ليكون فيه الخير له ولمملكته، فهو ما كان إلا لكشف مملكة سبأ، ومعرفة أحوالها، ومعرفة من يسوس أمورها، ويدبر شئونها.
قال صاحب الكشاف: ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة، ابتلاء له في علمه، وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط بما لم يحط به، لتتحاقر إليه نفسه، ويتصاغر إليه علمه، ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء، وأعظم بها فتنة ا هـ.
ثم فصل هذا النبأ وبينه بقوله:
(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) بين في هذا الكلام شئونهم الدنيوية وذكر منها ثلاثة أمور:
(1) إن ملكتهم امرأة وهي بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها من قبلها ملكا جليل القدر واسع الملك.
(2) إنها أوتيت من الثراء وأبهة الملك وما يلزم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال، الشيء الكثير الذي لا يوجد مثله إلا في الممالك العظمى.
(3) إن لها سريرا عظيما تجلس عليه، مرصّعا بالذهب وأنواع اللآلئ والجواهر في قصر كبير رفيع الشأن، وفى هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك وسعة رقعته ورفعة شأنه بين الممالك.
وبعد أن بين شئونهم الدنيوية ذكر معتقداتهم الدينية فقال:
(وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) أي وجدتها وقومها في ضلال مبين، فهم يعبدون الشمس لا ربّ الشمس وخالق الكون المحيط بكل شيء علما، وزين لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فظنوا حسنا ما ليس بالحسن، وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء والرسل وهو إخلاص السجود والعبادة لله وحده.
(أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) أي فصدهم عن السبيل حتى لا يهتدوا ويسجدوا لله الذي يظهر المخبوء في السموات والأرض كالمطر والنبات والمعادن المخبوءة في الأرض، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال كما قال: « سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ ».
ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه ومحتاجة إلى تدبيره، ذكر تعرف ما هو كالدليل على ذلك، فأبان أن أعظمها قدرا، وهو العرش الذي هو مركز تدبير شئون العالم هو الخالق له وهو محتاج إليه فقال:
(اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) أي هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو رب العرش العظيم، فكل عرش وإن عظم فهو دونه، فأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا.
[سورة النمل (27): الآيات 27 الى 31] قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31)
تفسير المفردات
تولّ عنهم: أي تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه، ليكون ما يقولونه بمسمع منك، فانظر: أي تأمل وفكّر، يرجعون: أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول ويدور بينهم بشأنه، والملأ: أشراف القوم وخاصة الملك، ألا تعلوا علي: أي ألا تتكبروا ولا تنقادوا للنفس والهوى، مسلمين: أي منقادين خاضعين.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر أن الهدهد أبدى المعاذير لتبرئة نفسه - أردف ذلك إجابة سليمن عن مقالة الهدهد، ثم أمره بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأ، والتنحي جانبا ليستمع ما يدور من الحديث بينها وبين خاصتها بشأنه.
الإيضاح
(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ؟) أي قال سنختبر مقالك، ونتعرف حقيقته بالامتحان، أصادق أنت فيما تقول، أم كاذب فيه لتتخلص من الوعيد؟
وفي التعبير بقوله: كنت من الكاذبين، دون أن يقول أم كذبت، إيذان بأن تلفيق الأقوال المنمّقة، واختيار الأسلوب الذي يستهوي السامع إلى قبولها من غير أن يكون لها حقيقة تعبر عنها - لا يصدر إلا ممّن مرن على الكذب وصار سجيّة له حتى لا يجد وسيلة للبعد عنه، وهذا يفيد أنه كاذب على أتم وجه، ومن كان كذلك لا يوثق به.
ثم شرع يفعل ما يختبره به فكتب له كتابا موجزا وأمره بتبليغه إلى ملكة سبأ فقال:
(اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) أي اذهب بهذا الكتاب فألقه إليهم، ثم تنح عنهم وكن قريبا منهم، واستمع مراجعة الملكة أهل مملكتها، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا ونقاشهم فيه.
ثم فصل ما دار بينهم بشأنه فقال:
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) أي وبعد أن ذهب الهدهد بالكتاب ألقاه إلى الملكة ففضّت خاتمه وقرأته، وجمعت أشراف قومها ومستشاريها وقالت تلك المقالة للمشورة، وطلبت أخذ الرأي في ذلك الخطب الذي نزل بها كتعرف ما هو دأب الدول الديمقراطية.
وفي الآية إيماء إلى أمور:
(1) سرعة الهدهد في إيصال الكتاب إليهم.
(2) إنه أوتى قوة المعرفة فاستطاع أن يفهم بالسمع كلامهم.
(3) إنها ترجمت ذلك الكتاب فورا بواسطة تراجمتها.
(4) إن من آداب رسل الملوك أن يتنحّوا قليلا عن المرسل إليهم بعد أداء الرسالة، ليتشاور المرسل إليهم فيها.
ثم بينت مصدر الكتاب وما فيه لخاصتها وذوي الرأي في مملكتها فقالت:
(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) ونص هذا الكتاب على وجازته يدل على أمور:
(1) إنه مشتمل على إثبات الإله ووحدانيته وقدرته وكونه رحمانا رحيما.
(2) نهيهم عن اتباع أهوائهم، ووجوب اتباعهم للحق.
(3) أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين.
وبهذا يكون الكتاب قد جمع كل ما لا بد منه في الدين والدنيا.
[سورة النمل (27): الآيات 32 الى 35] قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)
تفسير المفردات
أفتوني: أي أشيروا علي بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث، قاطعة أمرا: أي باتّة فيه منفذته، تشهدون: أي تحضروني، والمراد بالقوة: القوة الحسية وكثرة الآلات، والمراد بالبأس: النجدة والثبات في الحرب.
المعنى الجملي
ذكر فيما سلف أن الهدهد حيما ألقى الكتاب أحضرت بطانتها وأولى الرأي لديها وقرأت عليهم نصّ الكتاب، وهنا بين أنها طلبت إليهم إبداء آرائهم فيما عرض عليهم من هذا الخطب المدلهمّ والحادث الجلل حتى ينجلى لهم صواب الرأي فيما تعمل ويعملون، لأنها لا نريد أن تستبدّ بالأمر وحدها، فقلّبوا وجوه الرأي واشتد الحوار بينهم وكانت خاتمة المطاف أن قالوا: الرأي لدينا القتال، فإنا قوم أولو بأس ونجدة، والأمر مفوّض إليك فافعلى ما بدا لك، وإن قالت: إني أرى أن عاقبة الحرب والدمار والخراب وصيرورة العزيز ذليلا، وإني أرى أن نهادنه ونرسل إليه بهدية ثم ننظر ماذا يكون رده، علّه يقبل ذلك منا، ويكفّ عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه كل عام ونلتزم ذلك له، وبذا يترك قتالنا وحربنا:
الإيضاح
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ) أي قالت بلقيس لأشراف قومها: أيها الملأ أشيروا علي في أمر هذا الكتاب الذي ألقى إلي فإني لا أقضى فيه برأى حتى تشهدوني فأشاوركم فيه.
وفي قولها هذا دلالة على إجلالهم وتكريمهم ليمحضوها النصح، ويشيروا عليها بالصواب، ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضاءهم على الطاعة لها، علما منها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها، وتعمية في تقدير أمرهم، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم، ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) على مالها من عقل راجح وأدب جمّ في التخاطب.
وعلى هذا النهج سار الإسلام، فقد قال سبحانه لنبيه « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » وقد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله: « وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ».
فأجابوا عن مقالها:
(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) أي قال الملأ من قومها حين شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذوو بأس ونجدة في القتال، إلى ما لنا من وافر العدّة وعظيم العتاد وكثير الكراع والسلاح، وإن أمر القتال والسلم مفوّض إليك، فانظرى وقلّبى الرأي على وجوهه، ثم مرينا نأتمر بذلك.
ولما أحست منهم الميل إلى القتال شرعت تبين لهم وجه الصواب، وأنهم في غفلة عن قدرة سليمان وعظيم شأنه، إذ من سخر له الطير على الوجه الذي يريده ليس من السهل مجالدته والتغلب عليه.
(قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) أي قالت لهم حين عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان: إن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرها وإتلاف أموالها، وأذلوا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطنهم أو قتلوهم تقتيلا، ليتم هلم الملك والغلبة، وتتقرر لهم في النفوس المهابة، وهكذا يفعلون معنا.
وفي هذا تحذير شديد لقومها من مسير سليمان إليهم، ودخوله بلادهم.
وبعد أن أبانت ما في الحرب والمجالدة من الخطر أتبعته بما عزمت عليه من المسالمة بقولها:
(وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ؟) أي وإني سأرسل إليه هدية من نفائس الأموال لأتعرف حاله وأختبر أمره، أنبى هو أم ملك؟ فإن كان نبيا لم يقبلها ولم يرض منا إلا أن نتبعه على دينه، وإن كان ملكا قبل الهدية وانصرف إلى حين، فإن الهدايا مما تورث المودة، وتذهب العداوة، وفي الحديث: « تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء »
ولقد أحسن من قال:
هدايا الناس بعضهم لبعض تولّد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في الضمير هوى وودّا وتكسبهم إذا حضروا جمالا
[سورة النمل (27): الآيات 36 الى 37] فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37)
تفسير المفردات
لا قبل لهم بها: أي لا طاقة لهم بمقاومتها، صاغرون: أي مهانون محتقرون.
الإيضاح
لما وصلت الهدية مع الرسول إلى سليمان وكانت من ذهب وجواهر ولآلى وغيرها مما تقدمه الملوك العظام، قال سليمان للرسول: أتصانعونني بالمال لأترككم على شرككم وكفركم؟ لن يكون ذلك أبدا، إن الذي أعطانيه الله من النبوة والملك الواسع الأرجاء والمال الوفير - خير مما أنتم فيه، فلا حاجة لي بهديتكم، وليس رأيى في المال كما ترون، فأنتم تفرحون به دوني، فارجع بما جئت به إلى من أرسلك، ولنأتينكم بجنود لا طاقة لكم بدفعها ولا الانتصار عليها، ولنخرجنكم من أرضكم أذلة مأمورين مستعبدين، إن لم تأتونى مستسلمين منقادين.
[سورة النمل (27): الآيات 38 الى 40] قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40)
تفسير المفردات
العرش: سرير الملك، مسلمين أي خاضعين منقادين، العفريت من البشر: الخبيث الماكر الذي يعفر أقرانه، ومن الشياطين: المارد، مقامك: أي مجلسك الذي تجلس فيه للحكم، قوى: أي قادر على حمله لا أعجز عنه، أمين: أي على ما فيه من لآلئ وجواهر وغيرها، والكتاب: هو علم الوحي والشرائع، والذي عنده علم هو سليمان عليه السلام كما اختاره الرازي وقال إنه أقرب الآراء، يرتد: أي يرجع، والطرف: تحريك الأجفان والمراد بذلك السرعة العظيمة، مستقرا: أي ساكنا قارا على حاله التي كان عليها، الفضل: التفضل والإحسان، ليبلونى: أي ليعاملنى معاملة المختبر، أم أكفر أي أقصر في أداء واجب الشكر، كفر أي لم يشكر.
المعنى الجملي
استبان مما سلف أن سليمان رفض قبول الهدايا وتهدد الرسول بأن قومه وملكتهم إن لم يأتوا إليه طائعين خاضعين فسيوجه إليهم جيشا جرارا ينكل بهم أشد التنكيل، يقتل من يقتل ويأتي بالباقين أسارى وهم صاغرون، ويجليهم جميعا عن الديار والأوطان، ويأخذ أموالهم غنائم له - وهنا ذكر أنهم خافوا تهديده واستجابوا لدعوته، فتوجهت الملكة وأشراف قومها إليه، لكن سليمان رأى حين قربت من الوصول إليه أن يحضر سرير ملكها قبل مقدمها، ليكون في ذلك دلالة على قدرة الله وإثبات نبوته وتتظاهر عليها الأدلة من كل أوب، فسأل أعوانه: أيكم يستطيع أن يحضره قبل وصولها إلينا، فأجابه عفريت من الجن بأن في استطاعته أن يحضره قبل قيامه من مجلس الحكم والقضاء، فقال هو: بل أنا آتيكم به كلمح البصر، وقد كان كما قال: فرأى العرش حاضرا أمامه فشكر ربه على ما آتاه من النعم العظام الذي لا يستطيع إيفاء حقها من الشكر.
وعلينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم على أنه معجزة لسليمان، إذ هو لا ينطبق على السنن العادية التي وضعها ربنا لخلقه، فعلم البشر إلى الآن لم يصل إلى تحقيق ذلك عمليا مع تقدم سبل الانتقال، فالطائرات على سرعتها التي أدهشت العقول لا تستطيع أن تسافر من جنوب اليمن إلى أطراف الشام في مثل تلك اللحظات الوجيزة.
الإيضاح
لما رجعت الرسل إلى بلقيس وأخبرتها بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة إليك بأشراف قومي، لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه، من دينك، ثم شخصت إليه، فجعل يبعث الجن يأتونه بأخبارها ويعلمونه غاية سيرها كل يوم حتى إذا دنت منه جمع جنده من الجن والإنس وتكلم فيهم.
(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) أي قال أيها الأعوان من منكم في مكنته أن يأتينى بسرير ملكها قبل قدومها علينا، لنطلعها على بعض ما أنعم الله به علينا من العجائب النبوية، والآيات الإلهية، لتعرف صدق نبوتنا، ولتعلم أن ملكها في جانب عجائب الله وبدائع قدرته يسير، وحينئذ تقدّم إليه بعض جنده بمقترحات.
(قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) أي قال شيطان قوى أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس قضائك وكان إلى منتصف النهار، ثم زاد الأمر توكيدا فقال: وإني على الإتيان به لقادر لا أعجز عنه، وإني لأمين لا أمسه بسوء، ولا أقتطع منه شيئا لنفسى - حينئذ.
(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) أي قال سليمان للعفريت متحدثا بنعمة الله وعظيم فضله عليه: أنا أفعل ما لا تستطيع أنت، أنا أحضره في أقصر ما يكون مدة، أنا أحضره قبل ارتداد طرفك إليك، وقد كان كما قال:
(فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ؟) أي فلما رآه سليمان ساكنا ثابتا على حاله لم يتبدل منه شيء ولم يتغير وضعه الذي كان عليه قال هذا تفضل من الله ومنّة ليختبرنى: أأشكر بأن أراه فضلا منه بلا قوة مني أم أجحد فلا أشكر بل أنسب العمل إلى نفسي؟
وإن النعم الجسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن الله بها عباده، فمن ضل بها هوى، ومن شكرها ارتقى، وهذا ما عناه سبحانه بقوله:
(وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) أي ومن شكر ففائدة الشكر إليه، لأنه يجلب دوام النعمة، ومن جحد ولم يشكر فإن الله غني عن العباد وعبادتهم، كريم بالإنعام عليهم وإن لم يعبدوه، كما قال: « مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها » وقال: « وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ »
وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد دلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنتعرف على ما هى أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفّيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه ».
[سورة النمل (27): الآيات 41 الى 44] قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44)
تفسير المفردات
نكروا لها عرشها: أي غيروا هيئته وشكله بحيث لا يعرف بسهولة، مسلمين: أي خاضعين منقادين، صدها: أي منعها، والصرح: القصر وكل بناء عال، واللجة الماء الكثير، ممرد: أي ذو سطح أملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر في وجهه، القوارير: الزجاج واحدها قارورة، أسلمت: أي خضعت.
المعنى الجملي
علمنا مما سلف أن بلقيس تجهزت للسفر مقبلة إلى سليمان، وأن الجن كانت تترسم خطاها من يوم إلى آخر حتى إذا دنت منه سأل سليمان جنده: من يستطيع إحضار عرشها؟ فقال عفريت من الجن: أنا أفعل ذلك قبل أن تقوم من مجلس القضاء، فقال سليمان: بل أستطيع أن أحضره في لمح البصر وكان كما قال: فلما رآه أمامه شكر ربه على جزيل نعمه.
وهنا ذكر ما فعل سليمان من تغيير معالم العرش وتبديل أوضاعه، ثم سؤالها عنه ليختبر مقدار عقلها، ولتعلم صدق سليمان في دعواه النبوة، وتتظاهر لديها الأدلة على قدرة المولى سبحانه.
وقد كان مما أعده لنزولها قصر عظيم مبنى من الزجاج الشفاف، فرشت أرضه بالزجاج أيضا، وفى أسفله ماء جار فيه صنوف السمك، فلما دخلت في بهوه خالته لجة من الماء فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، فأنبأها سليمان بأن هذا زجاج يجرى تحته الماء، حينئذ أيقنت بأن دين سليمان هو الحق وأنها قد ظلمت نفسها بكفرها بالله ربها خالق السموات والأرض وصاحت تقول: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين
الإيضاح
(قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) أي قال سليمان لجنده لما جاء عرش بلقيس: غيروا لها معالم السرير وبدّلوا أوضاعه، لنختبر حالها إذا نظرت إليه ونرى: أتهتدي إليه وتعلم أنه هو أم لا تستبين لها حقيقة حاله؟.
ثم أشار إلى سرعة مجيها وخضوعها بقوله:
(فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ؟ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) أي فحين قدمت واطلعت على عرشها سئلت عنه، أعرشك مثل هذا؟ أجابت بما دل على رجاحة عقلها إذ قالت كأنه هو، ولم تجزم بأنه هو، إذ ربما كان مثله.
قال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر، وتعجب من حضوره عند سليمان فقالت: كأنه هو: وقال مقاتل: عرفته ولكنها شبّهت عليهم كما شبهوا عليها، ولو قيل لها أهذا عرشك لقالت نعم.
ولما ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار المعجزة لها قالت:
(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) أي وأوتينا العلم بكمال قدرة الله وصدق نبوتك من قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من أمر الهدهد، وبما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك، وكنا منقادين لك من ذلك الحين، فلا حاجة بي إلى إظهار معجزات أخرى.
ثم ذكر سبحانه ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك الحين فقال:
(وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) أي ومنعها ما كانت تعبده من دون الله وهو الشمس عن إظهار الإسلام والاعتراف بوحدانيته تعالى، من قبل أنها من قوم كانوا يعبدونها ونشأت بين أظهرهم ولم تكن قادرة على إظهار إسلامها إلى أن مثلت بين يدي سليمان فاستطاعت أن تنطق بما كانت تعتقده في قرارة نفسها ويجول في خاطرها.
روي أن سليمان أمر قبل مقدمها ببناء قصر عظيم جعل صحنه من زجاج أبيض شفاف يجرى من تحته الماء وألقى فيه دواب البحر من سمك وغيره، فلما قدمت إليه استقبلها فيه وجلس في صدره، فحين أرادت الوصول إليه حسبته ماء فكشفت عن ساقيها، لئلا تبتل أذيالها كتعرف على ما هى عادة من يخوض الماء، فقال لها سليمان: إن ما تظنينه ماء ليس بالماء، بل هو صرح قد صنع من الزجاج فسترت ساقيها وعجبت من ذلك، وعلمت أن هذا ملك أعزّ من ملكها، وسلطان أعز من سلطانها، ودعاها سليمان إلى عبادة الله وعليها على عبادة الشمس دون الله، فأجابته إلى ما طلب وقالت: رب إني ظلمت نفسي بالثبات على ما كنت عليه من الكفر، وأسلمت مع سليمان لله رب كل شيء وأخلصت له العبادة.
وإلى ما تقدم أشار سبحانه بقوله:
).
أخرج البخاري في تاريخه والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أول من صنعت له الحمامات سليمان ».
قصص صالح [سورة النمل (27): الآيات 45 الى 53] ولَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) ومَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53)
تفسير المفردات
فريقان: أي طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يختصمون: أي يجادل بعضهم بعضا ويحاجه، السيئة: العقوبة التي تسوء صاحبها، الحسنة: التوبة، لو لا: أي هلّا، وهي كلمة تفيد الحث على حصول ما بعدها، اطيرنا: أي تطايرنا وتشاء منا بك، طائركم: أي ما يصيبكم من الخير والشر، وسمى طائرا لأنه لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم، تفتنون: أي تختبرون بتعاقب السراء والضراء، والمراد بالمدينة: الحجر، والرهط والنفر: من الثلاثة إلى التسعة، تقاسموا: أي احلفوا، والبيات: مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلا، وليه: أي من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل، والمهلك: الهلاك، والمكر: التدبير الخفي لعمل الشر، والتدمير: الإهلاك، خاوية: أي خالية، لآية: أي لعبرة وموعظة.
الإيضاح
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) أي ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحا وقلنا لهم: اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تجعلوا معه إلها غيره.
وحين دعاهم إلى ذلك افترقوا فرقتين:
(1) فريق صدّق صالحا وآمن بما جاء به من عند ربه.
(2) فريق كذّبه وكفر بما جاء به.
وصارا يتجادلان ويتخاصمان، وكل منهما يقول أنا على الحق وخصمى على الباطل.
ثم ذكر أن صالحا استعطف المكذّبين وكانوا أكثر عددا وأشد عتوّا وعنادا حتى قالوا: « يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ».
(قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ؟) أي لم تستعجلون بالعقوبة التي يسوءكم نزولها بكم قبل حصول الخيرات التي بشّرتكم بها في الدنيا والآخرة إن أنتم آمنتم بي.
ثم نصحهم وطلب إليهم أن يستغفروا ربهم لعلهم يرحمون فقال:
(لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي هلّا تتوبون إلى الله من كفركم، فيغفر لكم عظيم جرمكم ويصفح عن عقوبتكم على ما أتيتم به من الخطايا، لعلكم ترحمون بقبولها، إذ قد جرت سنته ألا تقبل التوبة بعد نزول العقوبة.
ولما قال لهم صالح ما قال، وأبان لهم سبيل الرشاد أجابوه بفظاظة وغلظة.
(قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) أي قالوا: إنا تشاءمنا بك وبمن آمن معك، إذ زجرنا الطير فعلمنا أن سيصيبنا بك وبهم من المكاره ما لا قبل لنا به، ولم تزل في اختلاف وافتراق منذ اخترعتم دينكم وأصابنا القحط والجدب بسببكم.
وسمى التشاؤم تطيرا من قبل أنه كان من دأبهم أنهم إذا خرجوا مسافرين فمروا بطائر زجروه: أي رموه بحجر ونحوه، فإن مرّ سانحا بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسره تيمنوا به، وإن مر بارحا بأن مر من المياسر إلى الميامن تشاءموا منه.
فأجابهم صالح عليه السلام:
(قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ) أي قال إن ما يصيبكم من خير أو شر مكتوب عند الله وهو بقضائه وقدره، وليس شيء منه بيد غيره، فهو إن شاء رزقكم، وإن شاء حرمكم: وسمى ذلك القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فلا شى أسرع منه نزولا.
ثم أبان لهم سبب نزول ما ينزل من الشر بقوله:
(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) أي بل أنتم قوم يختبركم ربكم حين أرسلنى إليكم أتطيعونه فتعملوا بما أمركم به فيجزيكم الجزيل من ثوابه، أم تعصونه فتعملوا بخلافه فيحل بكم عقابه؟
ثم ذكر أن قريته كانت كثيرة الفساد فقال:
(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) أي وكان في مدينة صالح وهي الحجر تسعة أنفس يعيثون في الأرض فسادا لا يعملون فيها صالحا.
ثم بين بعض ما عملوا من الفساد:
(قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) أي قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة وتوعّدهم بقوله: « تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » احلفوا لنباغتّنه وأهله بالهلاك ليلا ثم لنقولن لأولياء الدم، ما حضرنا هلاكهم، ولا ندري من قتله ولا قتل أهله. ونحلف إنا لصادقون في قولنا.
وإذا كانوا لم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى، وأيضا فهم إذا لم يقتلوا الأتباع فأحربهم ألا يقتلوا صالحا.
قال الزجاج: كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيّتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه، وكان هذا مكرا منهم، ومن ثم قال سبحانه محذّرا لهم ولأمثالهم.
(وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح، إذ صاروا إليه ليلا ليقتلوه وأهله وهو لا يشعر بذلك، فأخذناهم بعقوبتنا، وعجلنا لهم العذاب من حيث لا يشعرون بمكر الله بهم.
ثم بين ما ترتب على ما باشروه من المكر بقوله:
(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) أي ففكر كيف آل أمرهم، وكيف كانت عاقبة مكرهم، فقد أهلكناهم وقومهم الذين لم يؤمنوا على وجه يقتضى النظر، ويسترعى الاعتبار، ويكون عظة لمن غدر كغدرهم في جميع الأزمان. روى أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلى فيه، فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه، فوقعت عليهم صخرة من جبالهم طبّقت عليهم الشعب فهلكهوا وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة، ونجّى الله صالحا ومن آمن معه.
ثم أكد ما تقدم وقرره بقوله:
(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا) أي فتلك مساكنهم أصبحت خالية منهم، إذ قد أهلكهم الله بظلمهم أنفسهم بشركهم به وتكذيبهم برسوله.
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي إن في فعلنا بثمود ما قصصناه عليك لعظة لمن كان من أولى المعرفة والعلم، فيعلم ارتباط الما هى اسباب بمسبباتها، والنتائج بمقدماتها، بحسب السنن التي وضعت في الكون.
وبعد أن ذكر من هلكوا أردفهم بمن أنجاهم فقال:
(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) أي وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود - رسولنا صالحا ومن آمن به، لأنهم كانوا يتقون سخط الله ويخافون شديد عقابه، بتصديقهم رسوله الذي أرسله إليهم.
وفي هذا إيماء إلى أن الله ينجى محمدا وأتباعه عند حلول العذاب بمشركي قريش حين يخرج من بين ظهرانيهم كما أحلّ بقوم صالح ما أحل حين خرج هو والمؤمنون إلى أطراف الشام ونزل رملة وفلسطين.
قصص لوط [سورة النمل (27): الآيات 54 الى 55] وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)
الإيضاح
(وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ؟) أي واذكر لقومك حديث لوط لقومه إذ قال لهم منذرا ومحذّرا: إنكم لتفعلون فاحشة لم يسبقكم بها أحد من بنى آدم، مع علمكم بقبحها لدى العقول والشرائع (واقتراف القبيح ممن يعلم قبحه أشنع).
ثم بين ما يأتون من الفاحشة بطريق التصريح بعد الإبهام ليكون أوقع في النفس فقال:
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) أي أينبغي أن تأتوا الرجال وتقودكم الشهوة إلى ذلك وتذروا النساء اللاتي فيهن محاسن الجمال، وفيهن مباهج الرجال، إنكم لقوم جاهلون سفهاء حمقى ما جنون.
ونحو الآية قوله: « أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ».
وقد أشار سبحانه إلى قبيح فعلهم وعظيم شناعته من وجوه:
(1) قوله: (الرِّجالَ) وفيه الإشارة إلى أن الحيوان الأعجم لا يرضى بمثل هذا.
(2) قوله: (مِنْ دُونِ النِّساءِ) وفى ذلك إيماء إلى أن تركهن واستبدال الرجال بهن خطأ شنيع وفعل قبيح.
(3) قوله: (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) وفى هذا إيماء إلى أنهم يفعلون فعل الجهلا الذين لا عقول لهم، ولا يدرون عظيم قبح ما يفعلون.
هذا آخر ما سطرناه تفسيرا لهذا الجزء من كلام ربنا العليم القدير، فله الحمد والمنة.
وكان ذلك بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[تتمة سورة النمل] بسم الله الرحمن الرحيم
[سورة النمل (27): الآيات 56 الى 58] فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)
تفسير المفردات
يتطهرون: أي ينزهون أنفسهم، ويتباعدون عما نفعله، ويزعمون أنه من القاذورات، قدّرنا: أي قضينا وحكمنا، الغابرين: أي الباقين في العذاب.
المعنى الجملي
سبق أن بيّنا أن الذين قسموا القرآن إلى أجزائه الثلاثين لاحظوا العدّ اللفظي للحروف والكلمات وعبارات والآيات، ولم ينظروا إلى ارتباط المعاني بعضها ببعض، ومن ثم نرى هنا أن الجزء قد انتهى قبل تمام قصة لوط وبدئ الجزء العشرون بتمام هذه القصة، وقد بين فيها أن النصح لم يجدهم شيئا وعقدوا العزم على استعمال القوة في إخراجه من بين ظهرانيّهم، ولم يكن لهم حجة على المعارضة إلا أن لوطا وقومه لا يريدون أن يشاركوهم فيما يفعلون تباعدا من الأرجاس، وتلك مقالة قالوها على سبيل الاستهزاء بهم، وقد نسوا أن هناك قوة أشد من قوتهم هي لهم بالمرصاد، وأنها تمهلهم ولا تهملهم، فلما حان حينهم جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأهلك الله القوم الظالمين، ونصر الحق وأزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
الإيضاح
(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) أي فلم يكن جوابهم للوط إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الذكور إلا قيل بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأهله من قريتنا، وقد عدّوا سكناه بينهم منّة ومكرمة عليه إذ قالوا: من قريتكم.
ثم عللوا هذا الإخراج بقولهم استهزاء بهم:
(إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) أي إنهم يتحرّجون من فعل ما تفعلون، ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم، فإنهم لا يصلحون لجواركم في بلدكم.
ولما وصلوا إلى هذا الحد من قبح الأفعال والأقوال دمّر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وإلى هذا أشار بقوله:
(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) أي فأهلكناهم وأنجينا لوطا وأهله إلا امرأته جعلناها بتقديرنا وحكمتنا من الباقين في العذاب، لأنها كانت على طريقتهم راضية بقبيح أفعالهم وكانت ترشد قومها إلى صيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لا كرامة لها.
ثم بين ما أهلكوا به فقال:
(وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) أي وأمطرنا عليهم مطرا غير ما عهد من نوعه، فقد كان حجارة من سجيل، فبئس ذلك المطر مطر الذين أنذرهم الله عقابا لهم على معصيتهم إياه، وخوّفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم.
[سورة النمل (27): الآيات 59 الى 64] قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهارًا وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزًا أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64)
تفسير المفردات
العباد المصطفون: هم الأنبياء عليهم السلام، الحدائق: البساتين واحدها حديقة، والبهجة: الحسن والرونق، يعدلون: من العدول وهو الانحراف، قرارا: أي مستقرا، الخلال: واحدها خلل وهو الوسط، رواسي: أي ثوابت أي جبالا ثوابت، الحاجز: الفاصل بين الشيئين، والمضطر: الذي أحوجته الشدة وألجأته الضراعة إلى الله، ويكشف: أي يرفع، خلفاء: من الخلافة وهي الملك والتسلط، يهديكم: أي يرشدكم، بين يدي رحمته: أي أمام المطر.
المعنى الجملي
بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص أولئك الأنبياء السالفين، وذكر أخبارهم الدالة على كمال قدرته وعظيم شأنه، وعلى ما خصهم به من المعجزات الباهرة الناطقة بجلال أقدارهم، وصدق أخبارهم، وفيها بيان صحة الإسلام والتوحيد وبطلان الشرك والكفر، وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى، ومن أعرض عنهم فقد تردّى في مهاوى الردى، ثم شرح صدره عليه الصلاة والسلام بما في تضاعيف تلك القصص من العلوم الإلهية، والمعارف الربانية، الفائضة من عالم القدس مقررا بذلك قوله: « وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ » أردف هذا أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحمده تعالى على تلك النعم، ويسلم على الأنبياء كافة عرفانا لفضلهم، وأداء الحق تقدمهم واجتهادهم في الدين، وتبليغ رسالات ربهم على أكمل الوجوه وأمثل السبل، ثم ذكر الأدلة على تفرده بالخلق والتقدير ووجوب عبادته وحده، وأنه لا ينبغي عبادة شيء سواه من الأصنام والأوثان.
الإيضاح
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) أمر الله رسوله أن يحمده شكرا له على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى، وأن يسلّم على عباده الذين اصطفاهم لرسالته، وهم أنبياؤه الكرام ورسله الأخيار.
ومن تلك النعم النجاة والنصر والتأييد لأوليائه، وحلول الخزي والنكال بأعدائه.
ونحو الآية قوله: « سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».
وفي هذا تعليم حسن، وأدب جميل، وبعث على التيمن بالذّكرين والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما، على قبول ما يلقى إلى السامعين، والإصغاء إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر: هذا الأدب، فحمدوا الله وصلّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد، وقبل كل عظة، وفى مفتتح كل خطبة، وتبعهم المتزسّلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن.
ثم شرع يوبخ المشركين ويتهكم بهم وينبههم إلى ضلالهم وجهلهم، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهار فقال:
(آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ؟) أي آلله الذي ذكرت لكم شئونه العظيمة خير أم الذي تشركون به من الأصنام؟ وفى ذلك ما لا يخفى من تسفيه آرائهم، وتفبيح معتقداتهم، وإلزامهم الحجة، إذ من البين أنه ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يوازن بينها وبين تعرف ما هو محض الخير، فهو من وادي ما حكاه سيبويه: تقول العرب: السعادة أحب إليك أم الشقاء؟ وكما قال حسان يهجو أبا سفيان بن حرب ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء
وجاء في بعض الآثار « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى، وأجل وأكرم »
هي سورة مكية نزلت بعد الشعراء، وآيها ثلاث وتسعون.
ومناسبتها ما قبلها من وجوه:
(1) إنها كالتتمة لها، إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء قصص داود وسليمان.
(2) إن فيها تفصيلا وبسطا لبعض القصص السالفة كقصص لوط وموسى عليهما السلام.
(3) إن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله.
(4) تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم، وإصرارهم على الكفر به، والإعراض عنه.
[سورة النمل (27): الآيات 1 الى 3] بسم الله الرحمن الرحيم
طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3)
الإيضاح
(طس) تقدم القول في المراد من فواتح السور، وأن الأصح أنها حروف مقطعة جاءت للتنبيه نحو ألا ويا التي للنداء، وينطق بأسمائها فيقال: (طا - سين).
(تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) أي إن هذه الآيات التي أنزلتها إليك أيها الرسول لآيات القرآن، وآيات كتاب بيّن لمن تدبره وفكر فيه أنه من عند الله أنزله إليك، لم تتقوّله أنت ولا أحد من خلقه، إذ لا يستطيع ذلك مخلوق ولو تظاهر معه الجن والإنس.
والمراد بالكتاب المبين: القرآن، وعطفه عليه كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما يقال هذا فعل السخي والجواد الكريم.
(هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) أي هي تزيد المؤمنين هدى على هداهم كما قال: « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » وهي تبشرهم برحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
ولما كان وصف الإيمان خفيا ذكر ما يلزمه من الأمور الظاهرة فقال:
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) أي إن المؤمنين حق الإيمان هم الذين يعملون الصالحات، فيقيمون الصلاة المفروضة على أكمل وجوهها، ويؤدون الزكاة التي تطهّر أموالهم وأنفسهم من الأرجاس، ويوقنون بالمعاد إلى ربهم، وأن هناك يوما يحاسبون فيه على أعمالهم خيرها وشرّها، فيذلّون أنفسهم في طاعته، رجاء ثوابه وخوف عقابه.
وليسوا كأولئك المكذبين به الذين لا يبالون. أحسنوا أم أساءوا، أطاعوا أم عصوا، لأنهم إن أحسنوا لا يرجون ثوابا، وإن أساءوا لم يخافوا عقابا.
[سورة النمل (27): الآيات 4 الى 5] إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5)
تفسير المفردات
يعمهون: أي يتحيرون ويترددون في أودية الضلال، الأخسرون: أي أشد الناس خسرانا، لحرمانهم الثواب، واستمرارهم في العذاب.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه أن المؤمنين يزيدهم القرآن هدى وبشرى، إذ هم به يستمسكون ويؤدون ما شرع من الأحكام على أتم الوجوه - أردف هذا ببيان أن من لا يؤمن بالآخرة يركب رأسه، ويتمادى في غيه، ويعرض عن القرآن أشد الإعراض، ومن ثم تراه حائرا مترددا في ضلاله، فهو في عذاب شديد في دنياه لتبلبله، وقلقه واضطراب نفسه، وفى الآخرة له أشد الخسران، لما يلحقه من النكال والوبال والحرمان من الثواب والنعيم الذي يتمتع به المؤمنون.
الإيضاح
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) أي إن الذين لا يصدقون بالآخرة وقيام الساعة والمعاد إلى الله بعد الموت، وبالثواب والعقاب - حبّبنا إليهم قبيح أعمالهم، ومددنا لهم في غيهم، فهم في ضلالهم حيارى تائهون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يفكرون في عقبى أمرهم، ولا ينظرون إلى ما يئول إليه سلوكهم.
قال الزجاج: أي جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه بأن جعلناه مشتهى بالطبع، محبوبا إلى النفس.
(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) في الدنيا بقتلهم وأسرهم حين قتال المؤمنين كما حدث يوم بدر.
(وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أي وهم في الآخرة أعظم خسرانا مما هم فيه في الدنيا، لأن عذابهم فيها مستمر لا ينقطع، وعذابهم في الدنيا ليس بدائم بل هو زائل لا بقاء له.
قصص موسى عليه السلام [سورة النمل (27): الآيات 6 الى 14] وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارًا سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)
تفسير المفردات
لتلقى: أي لتلقّن وتعطى، آنست: أي أبصرت إبصارا حصل لي به أنس، بخبر: أي عن الطريق وحاله، بشهاب: أي بشعلة نار، قبس: أي قطعة من النار مقبوسة ومأخوذة من أصلها، تصطلون: أي تستدفئون بها، قال الشاعر:
النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل
جان: أي حية صغيرة سريعة الحركة، ولّى مدبرا: أي التفت هاربا، ولم يعقب: أي لم يرجع على عقبه ولم يلتفت إلى ماوراءه من قولهم: عقّب المقاتل إذا كرّ بعد الفرّ، من غير سوء: أي من غير برص ولا نحوه من الآفات، آيات: أي معجزات دالة على صدقك، مبصرة: أي بينة واضحة، جحدوا بها: أي كذبوا، واستيقنتها أنفسهم: أي علمت علما يقينيا أنها من عند الله، وعلوا: أي ترفعا واستكبارا.
المعنى الجملي
بعد أن وصف عز اسمه القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين، وأن من أعرض عنه كان له الخسران المبين - أردفه بذكر حال المنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا له.
الإيضاح
(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) أي وإنك أيها الرسول لتحفظ القرآن وتعلّمه من عند حكيم بتدبير خلقه، عليم بأخبارهم وما فيه الخير لهم، فخبره هو الصدق، وحكمه هو العدل كما قال: « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ».
ثم خوطب صلى الله عليه وسلم وأمر بتلاوة بعض ما تلقاه من لدنه عز اسمه تقريرا لما قبله وتحقيقا له بقوله:
(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارًا سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي واذكر أيها الرسول لقومك حين قول موسى لأهله وقد ساربهم فضلّ الطريق في ليل دامس وظلام حالك، فرأى نارا تأجج وتضطرب، إني أبصرت نارا سآتيكم منها إما بخبر عن الطريق أو آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها، وكان كما قال: فإنه رجع منها بخبر عظيم، واقتبس نورا جليلا.
وقد كان هذا حين مسيره من مدين إلى مصر ولم يكن معه سوى امرأته، وكانا يسيران ليلا فاشتبه عليهما الطريق والبرد شديد.
وفي مثل هذه الحال يستبشر الناس بمشاهدة النار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة وأمن الطريق ومن الانتفاع بها للاصطلاء، ومن ثم قال لها هذه المقالة.
(فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي فلما وصل إلى النار نودى بأن بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، ومكانها هي البقعة المباركة المذكورة في قوله: « نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ » ومن حولها من في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات ومهبط الخيرات، لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتا.
وقوله سبحان الله تنزيه لنفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته وإيذان بأن مدبر ذلك الأمر هو رب العالمين.
أخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات (أنوار) وجهه كل شيء أدركه بصره » ثم قرأ أبو عبيدة « أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ».
وفي التوراة: جاء الله من سيناء، وأشرف من ساعير، واستعلى من جبل فاران، فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منها، واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم (وفاران مكة).
ولما تشوقت النفس إلى تحقيق ما يراد بالتصريح قال تعالى تمهيدا لما أراد إظهاره على يد موسى من المعجزات الباهرة:
(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي يا موسى إن الذي يخاطبك ويناجيك هو ربك الذي عزّ كل شيء وقهره، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله.
ثم أرى موسى آية تدل على قدرته، ليعلم ذلك علم شهود فقال:
(وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي وألق عصاك، فلما ألقاها انقلبت حية سريعة الحركة، فلما رآها كذلك ولّى هاربا خوفا منها ولم يلتفت وراءه من شدة فرقه.
وحينئذ تاقت النفس إلى معرفة ما قيل إذ ذاك فقال:
(يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) أي لا تخف مما ترى، فإني لا يخاف عندي رسلي وأنبيائى الذين اختصهم وأصطفيهم بالنبوة.
(إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي لكن من ظلم من سائر العباد، فإنه يخاف إلا إذا تاب، فبدل بتوبته حسنا بعد سوء، فإني أغفر له وأمحو ذنوبه وجميع آثارها كما فعل السحرة الذين آمنوا بموسى، وفى هذا بشارة عظيمة لسائر البشر، فإن من عمل ذنبا ثم أقلع عنه وتاب وأناب، فإن الله يتوب عليه كما قال: « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا ثُمَّ اهْتَدى » وقال: « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ».
ثم أراه جلت قدرته آية أخرى ذكرها بقوله:
) أي وأدخل يدك في جيب « مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر » فميصك تخرج بيضاء بياضا عظيما، ولها شعاع كشعاع الشمس بلا آفة بها من برص أو غيره.
والآية الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى حيوان، والثانية بتغيير يده نفسها وقلب أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية.
(فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) أي هاتان آيتان من تسع آيات أؤيدك بهن، وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه كما قال: « وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ».
ثم علل إرساله إليهم بالخوارق بقوله:
(إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ) أي لأنهم قوم خرجوا عما تقتضيه الفطرة ويوجبه العقل بادعاء فرعون الألوهية وتصديقهم له في ذلك.
وبعدئذ ذكر ما حدث لهم حين أتاهم بالبراهين من ربه فقال:
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي فلما جاءت فرعون وقومه أدلتنا الواضحة المنيرة الدالة على صدق الداعي - أنكروها وقالوا هذا سحر بين لائح يدل على مهارة فاعله وحذق صانعه.
ثم بين أن هذا التكذيب إنما كان باللسان فحسب لا بالقلب فقال:
(وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) أي وكذبوا بها بألسنتهم وأنكروا دلالتها على صدقه وأنه رسول من ربه، لكنهم علموا في قرارة نفوسهم أنها حق من عنده، فخالفت ألسنتهم قلوبهم، ظلما للآيات، إذ حطوها عن مرتبتها العالية وسمّوها سحرا، ترفعا عن الإيمان بها كما قال في آية أخرى: « فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْمًا عالِينَ ».
والخلاصة - إنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بها وهم يعلمون أنها من عند الله.
(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) أي فانظر أيها الرسول ما آل إليه أمر فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الذي فيه العبرة للظالمين، ومن إخراجهم من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم.
وفي هذا تحذير للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين لما جاء به من عند ربه، أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لعلهم يقلعون عن عنادهم واستكبارهم حتى لا تنزل بهم القوارع ويأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون.
قصص داود وسليمان عليهما السلام [سورة النمل (27): الآيات 15 الى 19] ولَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْمًا وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19)
تفسير المفردات
ورث سليمان داود: أي قام مقامه في النبوة والملك، منطق الطير: أي فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت، حشر: أي جمع، يوزعون: أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد، وادي النمل: واد بأرض الشام لا يحطمنكم: أي لا يكسرنكم ويهشمنكم، أوزعنى: أي يسر لي.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر قصص موسى صلى الله عليه وسلم تقريرا لما قبله ببيان أنه تلقاه من لدن حكيم عليم - أردفه قصص داود وسليمان، وذكر أنه آتى كلا منهما طائفة من علوم الدين والدنيا، فعلّم داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلّم سليمان منطق الطير، ثم بين أن سليمان طلب من ربه أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه وعلى والديه، وأن يمكنه من العمل الصالح وأن يدخله جنات النعيم.
الإيضاح
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْمًا، وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) أي ولقد أعطينا داود وسليمان ابنه عليهما السلام طائفة عظيمة من العلم، فعلمنا داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلمنا سليمان منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال ونحو ذلك مما لم نؤته أحدا ممن قبلهما، فشكر الله على ما أولاهما من مننه، وقالا الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن، على كثير من المؤمنين من عباده الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا.
وفي الآية إيماء إلى فضل العلم وشرف أهله من حيث شكرا عليه وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا شيئا دونه مما أوتياه من الملك العظيم: « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ » وفيها تحريض للعلماء على أن يحمدوا الله على ما آتاهم من فضله، وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن عباد الله من يفضلهم فيه.
(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) أي قام مقامه في النبوة والملك بعد موته، وسخّرت له الريح والشياطين.
قال قتادة في الآية: ورث نبوته وملكه وعلمه، وأعطى ما أعطى داود، وزيد له تسخير الريح والشياطين، وكان أعظم ملكا منه وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، شاكرا لنعم الله تعالى ا هـ.
ثم ذكر بعض نعم الله عليه:
(وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) أي وقال متحدثا بنعمة ربه، ومنبها إلى ما شرّفه به، ليكون أجدر بالقول: يا أيها الناس إن ربى يسرّ لي فهم ما يريده الطائر إذا صوّت، فأعطاني قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التي يومئ إليها فضلا منه ونعمة.
وقد اجتهد كثير من الباحثين في العصر الحاضر فعرفوا كثيرا من لغات الطيور أي تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة من حزن وفرح وحاجة إلى طعام وشراب واستغاثة من عدوّ، إلى نحو ذلك من الأغراض القليلة التي جعلها الله للطير.
وفي هذا معجزة لكتابه الكريم لقوله في آخر السورة: « وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها ».
وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيرا من الأمم تبحث في لغات الطيور والحيوان والحشرات كالنمل والنحل، وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع أغراضها، فكأنه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن وعلّمتها سليمان، وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتى، ويطلع الناس على عجائب صنعي فيها.
(وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ) مما نحتاج إليه في تدبير الملك، ويعيننا في ديننا ودنيانا.
وهذا أسلوب يراد به الكثرة من أي شيء، كما يقال فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء، وسيأتي في مقال الهدهد عن بلقيس. « وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ».
(إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) أي إن هذا الذي أوتيناه من الخيرات لهو الفضل المبين الذي لا يخفى على أحد.
ثم ذكر بعض ما أوتيه سليمان بقوله:
(وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي وجمع له عساكره من مختلف النواحي ليحارب بهم من لم يدخل في طاعته فهو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، وقال ابن عباس لكل صنف وزعة ترد أولاها على أخراها، لئلا تتقدمها في السير كما يصنع الملوك. وقال الحسن: لا بد للناس من وازع: أي سلطان يكفلهم. وقال عثمان بن عفان: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن.
(حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ: يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي حتى إذا أشرفوا على وادي النمل صاحت نملة بما فهم منه سليمان أنها تأمرهم بأن يدخلوا مساكنهم خوفا من تحطيم سليمن وجنوده لهم وهم لا يشعرون بذلك.
(فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) أي فضحك متعجبا من حذرها وتحذيرها والهداية التي غرسها الله فيها، مسرورا بما خصه الله من فهم مقاصدها، وقال رب ألهمنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل عملا تحبه وترضاه، وتوفنى مسلما وألحقنى بالصالحين من عبادك.
وخلاصة ذلك - كأنه قال: العلم غاية مطلبى وقد حصلت عليه، ولم يبق بعد ذلك إلا أن أطلب التوفيق للشكر عليه بالعمل الصالح الذي ترضاه، وأن أدخل في عداد الصالحين من آبائي الأنبياء وغيرهم.
تذكرة وعبرة بالآية قد دلّ بحث الباحثين في معيشة النمل على مالها من عجائب في معيشتها وتدبير شئونها، فإنها لتتخذ القرى في باطن الأرض، وتبنى بيوتها أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات، وتملؤها حبوبا وقوتا للشتاء، وتخفى ذلك في بيوت من مساكنها منعطفات إلى فوق، حذرا من ماء المطر.
وفي هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم والسياسة، فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى طريقة سياستها، وحكمتها وتذبيرها لأمورها، وأنها تفعل ما يفعل الملوك، وتدبّر وتسوس كما يسوس الحكام.
ولم يذكره الكتاب الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء، فيفهموا حال هذه الكائنات، وكيف أن النمل أجمعت أمرها على الفرار خوفا من الهلاك كما تجتمع على طلب المنافع، وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائهة في أودية الضلال، وهي أدنى حالا من الحشرات والديدان: « وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ».
[سورة النمل (27): الآيات 20 الى 26] وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)
تفسير المفردات
التفقد: طلب ما فقد، بسلطان مبين، أي بحجة واضحة، والإحاطة بالشيء علما علمه من جميع جهاته، وسبأ: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلة باليمن، ونبأ: أي خبر عظيم، والعرش: سرير الملك، عن السبيل: عن سبيل الحق والصواب والخبء: هو المخبوء من كل شيء كالمطر وغيره من شئون الغيب.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر في سابق الآيات أنه سخر لسليمان الجن والإنس والطير وجعلهم جنودا له - ذكر هنا أنه احتاج إلى جندى من جنوده وهو الهدهد، فبحث عنه فلم يجده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أبدى له عذرا يبرئه، فحضر بعد قليل وقص عليه خبر مملكة باليمن من أغنى الممالك وأقواها تحكمها امرأة هي بلقيس ملكة سبأ، ووصف له مالها من جلال الملك وأبّهته وأنها وقومها يعبدون الشمس لا خالق الشمس العليم بكل شيء في السموات والأرض، والعليم بما نخفى وما نعلن، والعليم بالسر والنجوى، وهو رب العرش العظيم.
الإيضاح
(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) أي وطلب ما فقد من الطير بحسب ما تقتضيه العناية بأمر الملك من الاهتمام بالرعايا ولا سيما الجند فقال: الهدهد حاضر ومنع مانع من رؤيته كساتر ونحوه؟ ثم لاح له أنه غائب فقال أم كان قد غاب قبل ذلك ولم أشعر به؟.
وخلاصة ذلك - أغاب عنى الهدهد الآن فلم أره حين تفقده، أم كان قد غاب من قبل ولم أشعر بغيبته.
ثم توعده بالعذاب إذا لم يجد سببا يبرر به غيبته فقال:
(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي لأعذبنه بحبسه مع ضده في قفص، ومن ثم قيل: أضيق السجون معاشرة الأضداد، أو بإبعاده من خدمتى، أو بإلزامه بخدمة أقرانه أو نحو ذلك، أو لأذبحنه ليعتبر به سواه أو ليأتينى بحجة تبين عذره.
والخلاصة - إنه ليعذبنه بأحد الأمرين الأولين إن لم يكن الأمر الثالث.
ثم ذكر أنه جاء بعد قليل وبين أن غيابه كان لأمر هامّ لدى سليمان.
(فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) أي فغاب مدة قصيرة بعد سؤال سليمان عنه ثم جاء فسأله: ما الذي أبطأ بك عني؟ فقال: اطلعت على ما لم تطلع أنت ولا جنودك عليه، على سعة علمك واتساع أطراف مملكتك.
وقد بدأ كلامه بهذا التمهيد، لترغيبه في الإصغاء إلى العذر، واستمالة قلبه إلى قبوله، ولبيان خطر ما شغله، وأنه أمر جليل الشأن يجب أن يتدبر فيه، ليكون فيه الخير له ولمملكته، فهو ما كان إلا لكشف مملكة سبأ، ومعرفة أحوالها، ومعرفة من يسوس أمورها، ويدبر شئونها.
قال صاحب الكشاف: ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة، ابتلاء له في علمه، وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط بما لم يحط به، لتتحاقر إليه نفسه، ويتصاغر إليه علمه، ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء، وأعظم بها فتنة ا هـ.
ثم فصل هذا النبأ وبينه بقوله:
(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) بين في هذا الكلام شئونهم الدنيوية وذكر منها ثلاثة أمور:
(1) إن ملكتهم امرأة وهي بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها من قبلها ملكا جليل القدر واسع الملك.
(2) إنها أوتيت من الثراء وأبهة الملك وما يلزم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال، الشيء الكثير الذي لا يوجد مثله إلا في الممالك العظمى.
(3) إن لها سريرا عظيما تجلس عليه، مرصّعا بالذهب وأنواع اللآلئ والجواهر في قصر كبير رفيع الشأن، وفى هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك وسعة رقعته ورفعة شأنه بين الممالك.
وبعد أن بين شئونهم الدنيوية ذكر معتقداتهم الدينية فقال:
(وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) أي وجدتها وقومها في ضلال مبين، فهم يعبدون الشمس لا ربّ الشمس وخالق الكون المحيط بكل شيء علما، وزين لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فظنوا حسنا ما ليس بالحسن، وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء والرسل وهو إخلاص السجود والعبادة لله وحده.
(أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) أي فصدهم عن السبيل حتى لا يهتدوا ويسجدوا لله الذي يظهر المخبوء في السموات والأرض كالمطر والنبات والمعادن المخبوءة في الأرض، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال كما قال: « سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ ».
ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه ومحتاجة إلى تدبيره، ذكر تعرف ما هو كالدليل على ذلك، فأبان أن أعظمها قدرا، وهو العرش الذي هو مركز تدبير شئون العالم هو الخالق له وهو محتاج إليه فقال:
(اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) أي هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو رب العرش العظيم، فكل عرش وإن عظم فهو دونه، فأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا.
[سورة النمل (27): الآيات 27 الى 31] قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31)
تفسير المفردات
تولّ عنهم: أي تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه، ليكون ما يقولونه بمسمع منك، فانظر: أي تأمل وفكّر، يرجعون: أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول ويدور بينهم بشأنه، والملأ: أشراف القوم وخاصة الملك، ألا تعلوا علي: أي ألا تتكبروا ولا تنقادوا للنفس والهوى، مسلمين: أي منقادين خاضعين.
المعنى الجملي
بعد أن ذكر أن الهدهد أبدى المعاذير لتبرئة نفسه - أردف ذلك إجابة سليمن عن مقالة الهدهد، ثم أمره بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأ، والتنحي جانبا ليستمع ما يدور من الحديث بينها وبين خاصتها بشأنه.
الإيضاح
(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ؟) أي قال سنختبر مقالك، ونتعرف حقيقته بالامتحان، أصادق أنت فيما تقول، أم كاذب فيه لتتخلص من الوعيد؟
وفي التعبير بقوله: كنت من الكاذبين، دون أن يقول أم كذبت، إيذان بأن تلفيق الأقوال المنمّقة، واختيار الأسلوب الذي يستهوي السامع إلى قبولها من غير أن يكون لها حقيقة تعبر عنها - لا يصدر إلا ممّن مرن على الكذب وصار سجيّة له حتى لا يجد وسيلة للبعد عنه، وهذا يفيد أنه كاذب على أتم وجه، ومن كان كذلك لا يوثق به.
ثم شرع يفعل ما يختبره به فكتب له كتابا موجزا وأمره بتبليغه إلى ملكة سبأ فقال:
(اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) أي اذهب بهذا الكتاب فألقه إليهم، ثم تنح عنهم وكن قريبا منهم، واستمع مراجعة الملكة أهل مملكتها، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا ونقاشهم فيه.
ثم فصل ما دار بينهم بشأنه فقال:
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) أي وبعد أن ذهب الهدهد بالكتاب ألقاه إلى الملكة ففضّت خاتمه وقرأته، وجمعت أشراف قومها ومستشاريها وقالت تلك المقالة للمشورة، وطلبت أخذ الرأي في ذلك الخطب الذي نزل بها كتعرف ما هو دأب الدول الديمقراطية.
وفي الآية إيماء إلى أمور:
(1) سرعة الهدهد في إيصال الكتاب إليهم.
(2) إنه أوتى قوة المعرفة فاستطاع أن يفهم بالسمع كلامهم.
(3) إنها ترجمت ذلك الكتاب فورا بواسطة تراجمتها.
(4) إن من آداب رسل الملوك أن يتنحّوا قليلا عن المرسل إليهم بعد أداء الرسالة، ليتشاور المرسل إليهم فيها.
ثم بينت مصدر الكتاب وما فيه لخاصتها وذوي الرأي في مملكتها فقالت:
(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) ونص هذا الكتاب على وجازته يدل على أمور:
(1) إنه مشتمل على إثبات الإله ووحدانيته وقدرته وكونه رحمانا رحيما.
(2) نهيهم عن اتباع أهوائهم، ووجوب اتباعهم للحق.
(3) أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين.
وبهذا يكون الكتاب قد جمع كل ما لا بد منه في الدين والدنيا.
[سورة النمل (27): الآيات 32 الى 35] قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)
تفسير المفردات
أفتوني: أي أشيروا علي بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث، قاطعة أمرا: أي باتّة فيه منفذته، تشهدون: أي تحضروني، والمراد بالقوة: القوة الحسية وكثرة الآلات، والمراد بالبأس: النجدة والثبات في الحرب.
المعنى الجملي
ذكر فيما سلف أن الهدهد حيما ألقى الكتاب أحضرت بطانتها وأولى الرأي لديها وقرأت عليهم نصّ الكتاب، وهنا بين أنها طلبت إليهم إبداء آرائهم فيما عرض عليهم من هذا الخطب المدلهمّ والحادث الجلل حتى ينجلى لهم صواب الرأي فيما تعمل ويعملون، لأنها لا نريد أن تستبدّ بالأمر وحدها، فقلّبوا وجوه الرأي واشتد الحوار بينهم وكانت خاتمة المطاف أن قالوا: الرأي لدينا القتال، فإنا قوم أولو بأس ونجدة، والأمر مفوّض إليك فافعلى ما بدا لك، وإن قالت: إني أرى أن عاقبة الحرب والدمار والخراب وصيرورة العزيز ذليلا، وإني أرى أن نهادنه ونرسل إليه بهدية ثم ننظر ماذا يكون رده، علّه يقبل ذلك منا، ويكفّ عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه كل عام ونلتزم ذلك له، وبذا يترك قتالنا وحربنا:
الإيضاح
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ) أي قالت بلقيس لأشراف قومها: أيها الملأ أشيروا علي في أمر هذا الكتاب الذي ألقى إلي فإني لا أقضى فيه برأى حتى تشهدوني فأشاوركم فيه.
وفي قولها هذا دلالة على إجلالهم وتكريمهم ليمحضوها النصح، ويشيروا عليها بالصواب، ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضاءهم على الطاعة لها، علما منها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها، وتعمية في تقدير أمرهم، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم، ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) على مالها من عقل راجح وأدب جمّ في التخاطب.
وعلى هذا النهج سار الإسلام، فقد قال سبحانه لنبيه « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » وقد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله: « وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ».
فأجابوا عن مقالها:
(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) أي قال الملأ من قومها حين شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذوو بأس ونجدة في القتال، إلى ما لنا من وافر العدّة وعظيم العتاد وكثير الكراع والسلاح، وإن أمر القتال والسلم مفوّض إليك، فانظرى وقلّبى الرأي على وجوهه، ثم مرينا نأتمر بذلك.
ولما أحست منهم الميل إلى القتال شرعت تبين لهم وجه الصواب، وأنهم في غفلة عن قدرة سليمان وعظيم شأنه، إذ من سخر له الطير على الوجه الذي يريده ليس من السهل مجالدته والتغلب عليه.
(قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) أي قالت لهم حين عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان: إن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرها وإتلاف أموالها، وأذلوا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطنهم أو قتلوهم تقتيلا، ليتم هلم الملك والغلبة، وتتقرر لهم في النفوس المهابة، وهكذا يفعلون معنا.
وفي هذا تحذير شديد لقومها من مسير سليمان إليهم، ودخوله بلادهم.
وبعد أن أبانت ما في الحرب والمجالدة من الخطر أتبعته بما عزمت عليه من المسالمة بقولها:
(وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ؟) أي وإني سأرسل إليه هدية من نفائس الأموال لأتعرف حاله وأختبر أمره، أنبى هو أم ملك؟ فإن كان نبيا لم يقبلها ولم يرض منا إلا أن نتبعه على دينه، وإن كان ملكا قبل الهدية وانصرف إلى حين، فإن الهدايا مما تورث المودة، وتذهب العداوة، وفي الحديث: « تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء »
ولقد أحسن من قال:
هدايا الناس بعضهم لبعض تولّد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في الضمير هوى وودّا وتكسبهم إذا حضروا جمالا
[سورة النمل (27): الآيات 36 الى 37] فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37)
تفسير المفردات
لا قبل لهم بها: أي لا طاقة لهم بمقاومتها، صاغرون: أي مهانون محتقرون.
الإيضاح
لما وصلت الهدية مع الرسول إلى سليمان وكانت من ذهب وجواهر ولآلى وغيرها مما تقدمه الملوك العظام، قال سليمان للرسول: أتصانعونني بالمال لأترككم على شرككم وكفركم؟ لن يكون ذلك أبدا، إن الذي أعطانيه الله من النبوة والملك الواسع الأرجاء والمال الوفير - خير مما أنتم فيه، فلا حاجة لي بهديتكم، وليس رأيى في المال كما ترون، فأنتم تفرحون به دوني، فارجع بما جئت به إلى من أرسلك، ولنأتينكم بجنود لا طاقة لكم بدفعها ولا الانتصار عليها، ولنخرجنكم من أرضكم أذلة مأمورين مستعبدين، إن لم تأتونى مستسلمين منقادين.
[سورة النمل (27): الآيات 38 الى 40] قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40)
تفسير المفردات
العرش: سرير الملك، مسلمين أي خاضعين منقادين، العفريت من البشر: الخبيث الماكر الذي يعفر أقرانه، ومن الشياطين: المارد، مقامك: أي مجلسك الذي تجلس فيه للحكم، قوى: أي قادر على حمله لا أعجز عنه، أمين: أي على ما فيه من لآلئ وجواهر وغيرها، والكتاب: هو علم الوحي والشرائع، والذي عنده علم هو سليمان عليه السلام كما اختاره الرازي وقال إنه أقرب الآراء، يرتد: أي يرجع، والطرف: تحريك الأجفان والمراد بذلك السرعة العظيمة، مستقرا: أي ساكنا قارا على حاله التي كان عليها، الفضل: التفضل والإحسان، ليبلونى: أي ليعاملنى معاملة المختبر، أم أكفر أي أقصر في أداء واجب الشكر، كفر أي لم يشكر.
المعنى الجملي
استبان مما سلف أن سليمان رفض قبول الهدايا وتهدد الرسول بأن قومه وملكتهم إن لم يأتوا إليه طائعين خاضعين فسيوجه إليهم جيشا جرارا ينكل بهم أشد التنكيل، يقتل من يقتل ويأتي بالباقين أسارى وهم صاغرون، ويجليهم جميعا عن الديار والأوطان، ويأخذ أموالهم غنائم له - وهنا ذكر أنهم خافوا تهديده واستجابوا لدعوته، فتوجهت الملكة وأشراف قومها إليه، لكن سليمان رأى حين قربت من الوصول إليه أن يحضر سرير ملكها قبل مقدمها، ليكون في ذلك دلالة على قدرة الله وإثبات نبوته وتتظاهر عليها الأدلة من كل أوب، فسأل أعوانه: أيكم يستطيع أن يحضره قبل وصولها إلينا، فأجابه عفريت من الجن بأن في استطاعته أن يحضره قبل قيامه من مجلس الحكم والقضاء، فقال هو: بل أنا آتيكم به كلمح البصر، وقد كان كما قال: فرأى العرش حاضرا أمامه فشكر ربه على ما آتاه من النعم العظام الذي لا يستطيع إيفاء حقها من الشكر.
وعلينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم على أنه معجزة لسليمان، إذ هو لا ينطبق على السنن العادية التي وضعها ربنا لخلقه، فعلم البشر إلى الآن لم يصل إلى تحقيق ذلك عمليا مع تقدم سبل الانتقال، فالطائرات على سرعتها التي أدهشت العقول لا تستطيع أن تسافر من جنوب اليمن إلى أطراف الشام في مثل تلك اللحظات الوجيزة.
الإيضاح
لما رجعت الرسل إلى بلقيس وأخبرتها بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة إليك بأشراف قومي، لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه، من دينك، ثم شخصت إليه، فجعل يبعث الجن يأتونه بأخبارها ويعلمونه غاية سيرها كل يوم حتى إذا دنت منه جمع جنده من الجن والإنس وتكلم فيهم.
(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) أي قال أيها الأعوان من منكم في مكنته أن يأتينى بسرير ملكها قبل قدومها علينا، لنطلعها على بعض ما أنعم الله به علينا من العجائب النبوية، والآيات الإلهية، لتعرف صدق نبوتنا، ولتعلم أن ملكها في جانب عجائب الله وبدائع قدرته يسير، وحينئذ تقدّم إليه بعض جنده بمقترحات.
(قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) أي قال شيطان قوى أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس قضائك وكان إلى منتصف النهار، ثم زاد الأمر توكيدا فقال: وإني على الإتيان به لقادر لا أعجز عنه، وإني لأمين لا أمسه بسوء، ولا أقتطع منه شيئا لنفسى - حينئذ.
(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) أي قال سليمان للعفريت متحدثا بنعمة الله وعظيم فضله عليه: أنا أفعل ما لا تستطيع أنت، أنا أحضره في أقصر ما يكون مدة، أنا أحضره قبل ارتداد طرفك إليك، وقد كان كما قال:
(فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ؟) أي فلما رآه سليمان ساكنا ثابتا على حاله لم يتبدل منه شيء ولم يتغير وضعه الذي كان عليه قال هذا تفضل من الله ومنّة ليختبرنى: أأشكر بأن أراه فضلا منه بلا قوة مني أم أجحد فلا أشكر بل أنسب العمل إلى نفسي؟
وإن النعم الجسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن الله بها عباده، فمن ضل بها هوى، ومن شكرها ارتقى، وهذا ما عناه سبحانه بقوله:
(وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) أي ومن شكر ففائدة الشكر إليه، لأنه يجلب دوام النعمة، ومن جحد ولم يشكر فإن الله غني عن العباد وعبادتهم، كريم بالإنعام عليهم وإن لم يعبدوه، كما قال: « مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها » وقال: « وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ »
وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد دلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنتعرف على ما هى أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفّيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه ».
[سورة النمل (27): الآيات 41 الى 44] قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44)
تفسير المفردات
نكروا لها عرشها: أي غيروا هيئته وشكله بحيث لا يعرف بسهولة، مسلمين: أي خاضعين منقادين، صدها: أي منعها، والصرح: القصر وكل بناء عال، واللجة الماء الكثير، ممرد: أي ذو سطح أملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر في وجهه، القوارير: الزجاج واحدها قارورة، أسلمت: أي خضعت.
المعنى الجملي
علمنا مما سلف أن بلقيس تجهزت للسفر مقبلة إلى سليمان، وأن الجن كانت تترسم خطاها من يوم إلى آخر حتى إذا دنت منه سأل سليمان جنده: من يستطيع إحضار عرشها؟ فقال عفريت من الجن: أنا أفعل ذلك قبل أن تقوم من مجلس القضاء، فقال سليمان: بل أستطيع أن أحضره في لمح البصر وكان كما قال: فلما رآه أمامه شكر ربه على جزيل نعمه.
وهنا ذكر ما فعل سليمان من تغيير معالم العرش وتبديل أوضاعه، ثم سؤالها عنه ليختبر مقدار عقلها، ولتعلم صدق سليمان في دعواه النبوة، وتتظاهر لديها الأدلة على قدرة المولى سبحانه.
وقد كان مما أعده لنزولها قصر عظيم مبنى من الزجاج الشفاف، فرشت أرضه بالزجاج أيضا، وفى أسفله ماء جار فيه صنوف السمك، فلما دخلت في بهوه خالته لجة من الماء فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، فأنبأها سليمان بأن هذا زجاج يجرى تحته الماء، حينئذ أيقنت بأن دين سليمان هو الحق وأنها قد ظلمت نفسها بكفرها بالله ربها خالق السموات والأرض وصاحت تقول: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين
الإيضاح
(قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) أي قال سليمان لجنده لما جاء عرش بلقيس: غيروا لها معالم السرير وبدّلوا أوضاعه، لنختبر حالها إذا نظرت إليه ونرى: أتهتدي إليه وتعلم أنه هو أم لا تستبين لها حقيقة حاله؟.
ثم أشار إلى سرعة مجيها وخضوعها بقوله:
(فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ؟ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) أي فحين قدمت واطلعت على عرشها سئلت عنه، أعرشك مثل هذا؟ أجابت بما دل على رجاحة عقلها إذ قالت كأنه هو، ولم تجزم بأنه هو، إذ ربما كان مثله.
قال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر، وتعجب من حضوره عند سليمان فقالت: كأنه هو: وقال مقاتل: عرفته ولكنها شبّهت عليهم كما شبهوا عليها، ولو قيل لها أهذا عرشك لقالت نعم.
ولما ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار المعجزة لها قالت:
(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) أي وأوتينا العلم بكمال قدرة الله وصدق نبوتك من قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من أمر الهدهد، وبما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك، وكنا منقادين لك من ذلك الحين، فلا حاجة بي إلى إظهار معجزات أخرى.
ثم ذكر سبحانه ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك الحين فقال:
(وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) أي ومنعها ما كانت تعبده من دون الله وهو الشمس عن إظهار الإسلام والاعتراف بوحدانيته تعالى، من قبل أنها من قوم كانوا يعبدونها ونشأت بين أظهرهم ولم تكن قادرة على إظهار إسلامها إلى أن مثلت بين يدي سليمان فاستطاعت أن تنطق بما كانت تعتقده في قرارة نفسها ويجول في خاطرها.
روي أن سليمان أمر قبل مقدمها ببناء قصر عظيم جعل صحنه من زجاج أبيض شفاف يجرى من تحته الماء وألقى فيه دواب البحر من سمك وغيره، فلما قدمت إليه استقبلها فيه وجلس في صدره، فحين أرادت الوصول إليه حسبته ماء فكشفت عن ساقيها، لئلا تبتل أذيالها كتعرف على ما هى عادة من يخوض الماء، فقال لها سليمان: إن ما تظنينه ماء ليس بالماء، بل هو صرح قد صنع من الزجاج فسترت ساقيها وعجبت من ذلك، وعلمت أن هذا ملك أعزّ من ملكها، وسلطان أعز من سلطانها، ودعاها سليمان إلى عبادة الله وعليها على عبادة الشمس دون الله، فأجابته إلى ما طلب وقالت: رب إني ظلمت نفسي بالثبات على ما كنت عليه من الكفر، وأسلمت مع سليمان لله رب كل شيء وأخلصت له العبادة.
وإلى ما تقدم أشار سبحانه بقوله:
).
أخرج البخاري في تاريخه والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أول من صنعت له الحمامات سليمان ».
قصص صالح [سورة النمل (27): الآيات 45 الى 53] ولَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) ومَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53)
تفسير المفردات
فريقان: أي طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يختصمون: أي يجادل بعضهم بعضا ويحاجه، السيئة: العقوبة التي تسوء صاحبها، الحسنة: التوبة، لو لا: أي هلّا، وهي كلمة تفيد الحث على حصول ما بعدها، اطيرنا: أي تطايرنا وتشاء منا بك، طائركم: أي ما يصيبكم من الخير والشر، وسمى طائرا لأنه لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم، تفتنون: أي تختبرون بتعاقب السراء والضراء، والمراد بالمدينة: الحجر، والرهط والنفر: من الثلاثة إلى التسعة، تقاسموا: أي احلفوا، والبيات: مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلا، وليه: أي من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل، والمهلك: الهلاك، والمكر: التدبير الخفي لعمل الشر، والتدمير: الإهلاك، خاوية: أي خالية، لآية: أي لعبرة وموعظة.
الإيضاح
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) أي ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحا وقلنا لهم: اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تجعلوا معه إلها غيره.
وحين دعاهم إلى ذلك افترقوا فرقتين:
(1) فريق صدّق صالحا وآمن بما جاء به من عند ربه.
(2) فريق كذّبه وكفر بما جاء به.
وصارا يتجادلان ويتخاصمان، وكل منهما يقول أنا على الحق وخصمى على الباطل.
ثم ذكر أن صالحا استعطف المكذّبين وكانوا أكثر عددا وأشد عتوّا وعنادا حتى قالوا: « يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ».
(قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ؟) أي لم تستعجلون بالعقوبة التي يسوءكم نزولها بكم قبل حصول الخيرات التي بشّرتكم بها في الدنيا والآخرة إن أنتم آمنتم بي.
ثم نصحهم وطلب إليهم أن يستغفروا ربهم لعلهم يرحمون فقال:
(لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي هلّا تتوبون إلى الله من كفركم، فيغفر لكم عظيم جرمكم ويصفح عن عقوبتكم على ما أتيتم به من الخطايا، لعلكم ترحمون بقبولها، إذ قد جرت سنته ألا تقبل التوبة بعد نزول العقوبة.
ولما قال لهم صالح ما قال، وأبان لهم سبيل الرشاد أجابوه بفظاظة وغلظة.
(قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) أي قالوا: إنا تشاءمنا بك وبمن آمن معك، إذ زجرنا الطير فعلمنا أن سيصيبنا بك وبهم من المكاره ما لا قبل لنا به، ولم تزل في اختلاف وافتراق منذ اخترعتم دينكم وأصابنا القحط والجدب بسببكم.
وسمى التشاؤم تطيرا من قبل أنه كان من دأبهم أنهم إذا خرجوا مسافرين فمروا بطائر زجروه: أي رموه بحجر ونحوه، فإن مرّ سانحا بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسره تيمنوا به، وإن مر بارحا بأن مر من المياسر إلى الميامن تشاءموا منه.
فأجابهم صالح عليه السلام:
(قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ) أي قال إن ما يصيبكم من خير أو شر مكتوب عند الله وهو بقضائه وقدره، وليس شيء منه بيد غيره، فهو إن شاء رزقكم، وإن شاء حرمكم: وسمى ذلك القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فلا شى أسرع منه نزولا.
ثم أبان لهم سبب نزول ما ينزل من الشر بقوله:
(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) أي بل أنتم قوم يختبركم ربكم حين أرسلنى إليكم أتطيعونه فتعملوا بما أمركم به فيجزيكم الجزيل من ثوابه، أم تعصونه فتعملوا بخلافه فيحل بكم عقابه؟
ثم ذكر أن قريته كانت كثيرة الفساد فقال:
(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) أي وكان في مدينة صالح وهي الحجر تسعة أنفس يعيثون في الأرض فسادا لا يعملون فيها صالحا.
ثم بين بعض ما عملوا من الفساد:
(قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) أي قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة وتوعّدهم بقوله: « تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » احلفوا لنباغتّنه وأهله بالهلاك ليلا ثم لنقولن لأولياء الدم، ما حضرنا هلاكهم، ولا ندري من قتله ولا قتل أهله. ونحلف إنا لصادقون في قولنا.
وإذا كانوا لم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى، وأيضا فهم إذا لم يقتلوا الأتباع فأحربهم ألا يقتلوا صالحا.
قال الزجاج: كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيّتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه، وكان هذا مكرا منهم، ومن ثم قال سبحانه محذّرا لهم ولأمثالهم.
(وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح، إذ صاروا إليه ليلا ليقتلوه وأهله وهو لا يشعر بذلك، فأخذناهم بعقوبتنا، وعجلنا لهم العذاب من حيث لا يشعرون بمكر الله بهم.
ثم بين ما ترتب على ما باشروه من المكر بقوله:
(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) أي ففكر كيف آل أمرهم، وكيف كانت عاقبة مكرهم، فقد أهلكناهم وقومهم الذين لم يؤمنوا على وجه يقتضى النظر، ويسترعى الاعتبار، ويكون عظة لمن غدر كغدرهم في جميع الأزمان. روى أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلى فيه، فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه، فوقعت عليهم صخرة من جبالهم طبّقت عليهم الشعب فهلكهوا وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة، ونجّى الله صالحا ومن آمن معه.
ثم أكد ما تقدم وقرره بقوله:
(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا) أي فتلك مساكنهم أصبحت خالية منهم، إذ قد أهلكهم الله بظلمهم أنفسهم بشركهم به وتكذيبهم برسوله.
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي إن في فعلنا بثمود ما قصصناه عليك لعظة لمن كان من أولى المعرفة والعلم، فيعلم ارتباط الما هى اسباب بمسبباتها، والنتائج بمقدماتها، بحسب السنن التي وضعت في الكون.
وبعد أن ذكر من هلكوا أردفهم بمن أنجاهم فقال:
(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) أي وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود - رسولنا صالحا ومن آمن به، لأنهم كانوا يتقون سخط الله ويخافون شديد عقابه، بتصديقهم رسوله الذي أرسله إليهم.
وفي هذا إيماء إلى أن الله ينجى محمدا وأتباعه عند حلول العذاب بمشركي قريش حين يخرج من بين ظهرانيهم كما أحلّ بقوم صالح ما أحل حين خرج هو والمؤمنون إلى أطراف الشام ونزل رملة وفلسطين.
قصص لوط [سورة النمل (27): الآيات 54 الى 55] وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)
الإيضاح
(وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ؟) أي واذكر لقومك حديث لوط لقومه إذ قال لهم منذرا ومحذّرا: إنكم لتفعلون فاحشة لم يسبقكم بها أحد من بنى آدم، مع علمكم بقبحها لدى العقول والشرائع (واقتراف القبيح ممن يعلم قبحه أشنع).
ثم بين ما يأتون من الفاحشة بطريق التصريح بعد الإبهام ليكون أوقع في النفس فقال:
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) أي أينبغي أن تأتوا الرجال وتقودكم الشهوة إلى ذلك وتذروا النساء اللاتي فيهن محاسن الجمال، وفيهن مباهج الرجال، إنكم لقوم جاهلون سفهاء حمقى ما جنون.
ونحو الآية قوله: « أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ».
وقد أشار سبحانه إلى قبيح فعلهم وعظيم شناعته من وجوه:
(1) قوله: (الرِّجالَ) وفيه الإشارة إلى أن الحيوان الأعجم لا يرضى بمثل هذا.
(2) قوله: (مِنْ دُونِ النِّساءِ) وفى ذلك إيماء إلى أن تركهن واستبدال الرجال بهن خطأ شنيع وفعل قبيح.
(3) قوله: (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) وفى هذا إيماء إلى أنهم يفعلون فعل الجهلا الذين لا عقول لهم، ولا يدرون عظيم قبح ما يفعلون.
هذا آخر ما سطرناه تفسيرا لهذا الجزء من كلام ربنا العليم القدير، فله الحمد والمنة.
وكان ذلك بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[تتمة سورة النمل] بسم الله الرحمن الرحيم
[سورة النمل (27): الآيات 56 الى 58] فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)
تفسير المفردات
يتطهرون: أي ينزهون أنفسهم، ويتباعدون عما نفعله، ويزعمون أنه من القاذورات، قدّرنا: أي قضينا وحكمنا، الغابرين: أي الباقين في العذاب.
المعنى الجملي
سبق أن بيّنا أن الذين قسموا القرآن إلى أجزائه الثلاثين لاحظوا العدّ اللفظي للحروف والكلمات وعبارات والآيات، ولم ينظروا إلى ارتباط المعاني بعضها ببعض، ومن ثم نرى هنا أن الجزء قد انتهى قبل تمام قصة لوط وبدئ الجزء العشرون بتمام هذه القصة، وقد بين فيها أن النصح لم يجدهم شيئا وعقدوا العزم على استعمال القوة في إخراجه من بين ظهرانيّهم، ولم يكن لهم حجة على المعارضة إلا أن لوطا وقومه لا يريدون أن يشاركوهم فيما يفعلون تباعدا من الأرجاس، وتلك مقالة قالوها على سبيل الاستهزاء بهم، وقد نسوا أن هناك قوة أشد من قوتهم هي لهم بالمرصاد، وأنها تمهلهم ولا تهملهم، فلما حان حينهم جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأهلك الله القوم الظالمين، ونصر الحق وأزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
الإيضاح
(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) أي فلم يكن جوابهم للوط إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الذكور إلا قيل بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأهله من قريتنا، وقد عدّوا سكناه بينهم منّة ومكرمة عليه إذ قالوا: من قريتكم.
ثم عللوا هذا الإخراج بقولهم استهزاء بهم:
(إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) أي إنهم يتحرّجون من فعل ما تفعلون، ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم، فإنهم لا يصلحون لجواركم في بلدكم.
ولما وصلوا إلى هذا الحد من قبح الأفعال والأقوال دمّر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وإلى هذا أشار بقوله:
(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) أي فأهلكناهم وأنجينا لوطا وأهله إلا امرأته جعلناها بتقديرنا وحكمتنا من الباقين في العذاب، لأنها كانت على طريقتهم راضية بقبيح أفعالهم وكانت ترشد قومها إلى صيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لا كرامة لها.
ثم بين ما أهلكوا به فقال:
(وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) أي وأمطرنا عليهم مطرا غير ما عهد من نوعه، فقد كان حجارة من سجيل، فبئس ذلك المطر مطر الذين أنذرهم الله عقابا لهم على معصيتهم إياه، وخوّفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم.
[سورة النمل (27): الآيات 59 الى 64] قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهارًا وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزًا أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64)
تفسير المفردات
العباد المصطفون: هم الأنبياء عليهم السلام، الحدائق: البساتين واحدها حديقة، والبهجة: الحسن والرونق، يعدلون: من العدول وهو الانحراف، قرارا: أي مستقرا، الخلال: واحدها خلل وهو الوسط، رواسي: أي ثوابت أي جبالا ثوابت، الحاجز: الفاصل بين الشيئين، والمضطر: الذي أحوجته الشدة وألجأته الضراعة إلى الله، ويكشف: أي يرفع، خلفاء: من الخلافة وهي الملك والتسلط، يهديكم: أي يرشدكم، بين يدي رحمته: أي أمام المطر.
المعنى الجملي
بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص أولئك الأنبياء السالفين، وذكر أخبارهم الدالة على كمال قدرته وعظيم شأنه، وعلى ما خصهم به من المعجزات الباهرة الناطقة بجلال أقدارهم، وصدق أخبارهم، وفيها بيان صحة الإسلام والتوحيد وبطلان الشرك والكفر، وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى، ومن أعرض عنهم فقد تردّى في مهاوى الردى، ثم شرح صدره عليه الصلاة والسلام بما في تضاعيف تلك القصص من العلوم الإلهية، والمعارف الربانية، الفائضة من عالم القدس مقررا بذلك قوله: « وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ » أردف هذا أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحمده تعالى على تلك النعم، ويسلم على الأنبياء كافة عرفانا لفضلهم، وأداء الحق تقدمهم واجتهادهم في الدين، وتبليغ رسالات ربهم على أكمل الوجوه وأمثل السبل، ثم ذكر الأدلة على تفرده بالخلق والتقدير ووجوب عبادته وحده، وأنه لا ينبغي عبادة شيء سواه من الأصنام والأوثان.
الإيضاح
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) أمر الله رسوله أن يحمده شكرا له على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى، وأن يسلّم على عباده الذين اصطفاهم لرسالته، وهم أنبياؤه الكرام ورسله الأخيار.
ومن تلك النعم النجاة والنصر والتأييد لأوليائه، وحلول الخزي والنكال بأعدائه.
ونحو الآية قوله: « سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».
وفي هذا تعليم حسن، وأدب جميل، وبعث على التيمن بالذّكرين والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما، على قبول ما يلقى إلى السامعين، والإصغاء إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر: هذا الأدب، فحمدوا الله وصلّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد، وقبل كل عظة، وفى مفتتح كل خطبة، وتبعهم المتزسّلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن.
ثم شرع يوبخ المشركين ويتهكم بهم وينبههم إلى ضلالهم وجهلهم، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهار فقال:
(آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ؟) أي آلله الذي ذكرت لكم شئونه العظيمة خير أم الذي تشركون به من الأصنام؟ وفى ذلك ما لا يخفى من تسفيه آرائهم، وتفبيح معتقداتهم، وإلزامهم الحجة، إذ من البين أنه ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يوازن بينها وبين تعرف ما هو محض الخير، فهو من وادي ما حكاه سيبويه: تقول العرب: السعادة أحب إليك أم الشقاء؟ وكما قال حسان يهجو أبا سفيان بن حرب ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء
وجاء في بعض الآثار « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى، وأجل وأكرم »